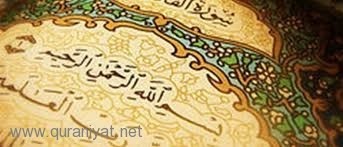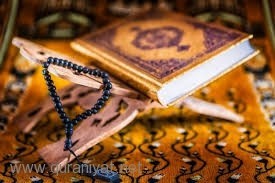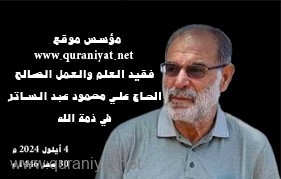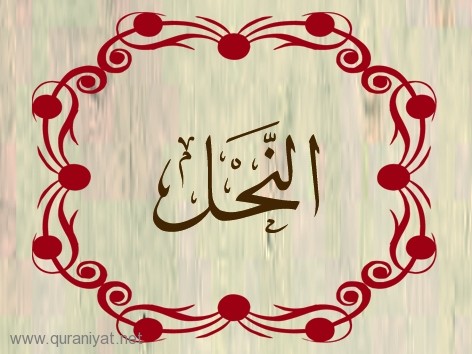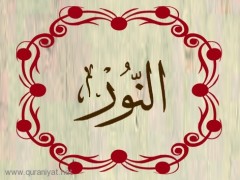- القرآن الكريم
- سور القرآن الكريم
- 1- سورة الفاتحة
- 2- سورة البقرة
- 3- سورة آل عمران
- 4- سورة النساء
- 5- سورة المائدة
- 6- سورة الأنعام
- 7- سورة الأعراف
- 8- سورة الأنفال
- 9- سورة التوبة
- 10- سورة يونس
- 11- سورة هود
- 12- سورة يوسف
- 13- سورة الرعد
- 14- سورة إبراهيم
- 15- سورة الحجر
- 16- سورة النحل
- 17- سورة الإسراء
- 18- سورة الكهف
- 19- سورة مريم
- 20- سورة طه
- 21- سورة الأنبياء
- 22- سورة الحج
- 23- سورة المؤمنون
- 24- سورة النور
- 25- سورة الفرقان
- 26- سورة الشعراء
- 27- سورة النمل
- 28- سورة القصص
- 29- سورة العنكبوت
- 30- سورة الروم
- 31- سورة لقمان
- 32- سورة السجدة
- 33- سورة الأحزاب
- 34- سورة سبأ
- 35- سورة فاطر
- 36- سورة يس
- 37- سورة الصافات
- 38- سورة ص
- 39- سورة الزمر
- 40- سورة غافر
- 41- سورة فصلت
- 42- سورة الشورى
- 43- سورة الزخرف
- 44- سورة الدخان
- 45- سورة الجاثية
- 46- سورة الأحقاف
- 47- سورة محمد
- 48- سورة الفتح
- 49- سورة الحجرات
- 50- سورة ق
- 51- سورة الذاريات
- 52- سورة الطور
- 53- سورة النجم
- 54- سورة القمر
- 55- سورة الرحمن
- 56- سورة الواقعة
- 57- سورة الحديد
- 58- سورة المجادلة
- 59- سورة الحشر
- 60- سورة الممتحنة
- 61- سورة الصف
- 62- سورة الجمعة
- 63- سورة المنافقون
- 64- سورة التغابن
- 65- سورة الطلاق
- 66- سورة التحريم
- 67- سورة الملك
- 68- سورة القلم
- 69- سورة الحاقة
- 70- سورة المعارج
- 71- سورة نوح
- 72- سورة الجن
- 73- سورة المزمل
- 74- سورة المدثر
- 75- سورة القيامة
- 76- سورة الإنسان
- 77- سورة المرسلات
- 78- سورة النبأ
- 79- سورة النازعات
- 80- سورة عبس
- 81- سورة التكوير
- 82- سورة الانفطار
- 83- سورة المطففين
- 84- سورة الانشقاق
- 85- سورة البروج
- 86- سورة الطارق
- 87- سورة الأعلى
- 88- سورة الغاشية
- 89- سورة الفجر
- 90- سورة البلد
- 91- سورة الشمس
- 92- سورة الليل
- 93- سورة الضحى
- 94- سورة الشرح
- 95- سورة التين
- 96- سورة العلق
- 97- سورة القدر
- 98- سورة البينة
- 99- سورة الزلزلة
- 100- سورة العاديات
- 101- سورة القارعة
- 102- سورة التكاثر
- 103- سورة العصر
- 104- سورة الهمزة
- 105- سورة الفيل
- 106- سورة قريش
- 107- سورة الماعون
- 108- سورة الكوثر
- 109- سورة الكافرون
- 110- سورة النصر
- 111- سورة المسد
- 112- سورة الإخلاص
- 113- سورة الفلق
- 114- سورة الناس
- سور القرآن الكريم
- تفسير القرآن الكريم
- تصنيف القرآن الكريم
- آيات العقيدة
- آيات الشريعة
- آيات القوانين والتشريع
- آيات المفاهيم الأخلاقية
- آيات الآفاق والأنفس
- آيات الأنبياء والرسل
- آيات الانبياء والرسل عليهم الصلاة السلام
- سيدنا آدم عليه السلام
- سيدنا إدريس عليه السلام
- سيدنا نوح عليه السلام
- سيدنا هود عليه السلام
- سيدنا صالح عليه السلام
- سيدنا إبراهيم عليه السلام
- سيدنا إسماعيل عليه السلام
- سيدنا إسحاق عليه السلام
- سيدنا لوط عليه السلام
- سيدنا يعقوب عليه السلام
- سيدنا يوسف عليه السلام
- سيدنا شعيب عليه السلام
- سيدنا موسى عليه السلام
- بنو إسرائيل
- سيدنا هارون عليه السلام
- سيدنا داود عليه السلام
- سيدنا سليمان عليه السلام
- سيدنا أيوب عليه السلام
- سيدنا يونس عليه السلام
- سيدنا إلياس عليه السلام
- سيدنا اليسع عليه السلام
- سيدنا ذي الكفل عليه السلام
- سيدنا لقمان عليه السلام
- سيدنا زكريا عليه السلام
- سيدنا يحي عليه السلام
- سيدنا عيسى عليه السلام
- أهل الكتاب اليهود النصارى
- الصابئون والمجوس
- الاتعاظ بالسابقين
- النظر في عاقبة الماضين
- السيدة مريم عليها السلام ملحق
- آيات الناس وصفاتهم
- أنواع الناس
- صفات الإنسان
- صفات الأبراروجزائهم
- صفات الأثمين وجزائهم
- صفات الأشقى وجزائه
- صفات أعداء الرسل عليهم السلام
- صفات الأعراب
- صفات أصحاب الجحيم وجزائهم
- صفات أصحاب الجنة وحياتهم فيها
- صفات أصحاب الشمال وجزائهم
- صفات أصحاب النار وجزائهم
- صفات أصحاب اليمين وجزائهم
- صفات أولياءالشيطان وجزائهم
- صفات أولياء الله وجزائهم
- صفات أولي الألباب وجزائهم
- صفات الجاحدين وجزائهم
- صفات حزب الشيطان وجزائهم
- صفات حزب الله تعالى وجزائهم
- صفات الخائفين من الله ومن عذابه وجزائهم
- صفات الخائنين في الحرب وجزائهم
- صفات الخائنين في الغنيمة وجزائهم
- صفات الخائنين للعهود وجزائهم
- صفات الخائنين للناس وجزائهم
- صفات الخاسرين وجزائهم
- صفات الخاشعين وجزائهم
- صفات الخاشين الله تعالى وجزائهم
- صفات الخاضعين لله تعالى وجزائهم
- صفات الذاكرين الله تعالى وجزائهم
- صفات الذين يتبعون أهواءهم وجزائهم
- صفات الذين يريدون الحياة الدنيا وجزائهم
- صفات الذين يحبهم الله تعالى
- صفات الذين لايحبهم الله تعالى
- صفات الذين يشترون بآيات الله وبعهده
- صفات الذين يصدون عن سبيل الله تعالى وجزائهم
- صفات الذين يعملون السيئات وجزائهم
- صفات الذين لايفلحون
- صفات الذين يهديهم الله تعالى
- صفات الذين لا يهديهم الله تعالى
- صفات الراشدين وجزائهم
- صفات الرسل عليهم السلام
- صفات الشاكرين وجزائهم
- صفات الشهداء وجزائهم وحياتهم عند ربهم
- صفات الصالحين وجزائهم
- صفات الصائمين وجزائهم
- صفات الصابرين وجزائهم
- صفات الصادقين وجزائهم
- صفات الصدِّقين وجزائهم
- صفات الضالين وجزائهم
- صفات المُضَّلّين وجزائهم
- صفات المُضِلّين. وجزائهم
- صفات الطاغين وجزائهم
- صفات الظالمين وجزائهم
- صفات العابدين وجزائهم
- صفات عباد الرحمن وجزائهم
- صفات الغافلين وجزائهم
- صفات الغاوين وجزائهم
- صفات الفائزين وجزائهم
- صفات الفارّين من القتال وجزائهم
- صفات الفاسقين وجزائهم
- صفات الفجار وجزائهم
- صفات الفخورين وجزائهم
- صفات القانتين وجزائهم
- صفات الكاذبين وجزائهم
- صفات المكذِّبين وجزائهم
- صفات الكافرين وجزائهم
- صفات اللامزين والهامزين وجزائهم
- صفات المؤمنين بالأديان السماوية وجزائهم
- صفات المبطلين وجزائهم
- صفات المتذكرين وجزائهم
- صفات المترفين وجزائهم
- صفات المتصدقين وجزائهم
- صفات المتقين وجزائهم
- صفات المتكبرين وجزائهم
- صفات المتوكلين على الله وجزائهم
- صفات المرتدين وجزائهم
- صفات المجاهدين في سبيل الله وجزائهم
- صفات المجرمين وجزائهم
- صفات المحسنين وجزائهم
- صفات المخبتين وجزائهم
- صفات المختلفين والمتفرقين من أهل الكتاب وجزائهم
- صفات المُخلَصين وجزائهم
- صفات المستقيمين وجزائهم
- صفات المستكبرين وجزائهم
- صفات المستهزئين بآيات الله وجزائهم
- صفات المستهزئين بالدين وجزائهم
- صفات المسرفين وجزائهم
- صفات المسلمين وجزائهم
- صفات المشركين وجزائهم
- صفات المصَدِّقين وجزائهم
- صفات المصلحين وجزائهم
- صفات المصلين وجزائهم
- صفات المضعفين وجزائهم
- صفات المطففين للكيل والميزان وجزائهم
- صفات المعتدين وجزائهم
- صفات المعتدين على الكعبة وجزائهم
- صفات المعرضين وجزائهم
- صفات المغضوب عليهم وجزائهم
- صفات المُفترين وجزائهم
- صفات المفسدين إجتماعياَ وجزائهم
- صفات المفسدين دينيًا وجزائهم
- صفات المفلحين وجزائهم
- صفات المقاتلين في سبيل الله وجزائهم
- صفات المقربين الى الله تعالى وجزائهم
- صفات المقسطين وجزائهم
- صفات المقلدين وجزائهم
- صفات الملحدين وجزائهم
- صفات الملحدين في آياته
- صفات الملعونين وجزائهم
- صفات المنافقين ومثلهم ومواقفهم وجزائهم
- صفات المهتدين وجزائهم
- صفات ناقضي العهود وجزائهم
- صفات النصارى
- صفات اليهود و النصارى
- آيات الرسول محمد (ص) والقرآن الكريم
- آيات المحاورات المختلفة - الأمثال - التشبيهات والمقارنة بين الأضداد
- نهج البلاغة
- تصنيف نهج البلاغة
- دراسات حول نهج البلاغة
- الصحيفة السجادية
- تصنيف الصحيفة السجادية
- تصنيف الصحيفة بالموضوعات
- الباب السابع : باب الاخلاق
- الباب الثامن : باب الطاعات
- الباب التاسع: باب الذكر والدعاء
- الباب العاشر: باب السياسة
- الباب الحادي عشر:باب الإقتصاد
- الباب الثاني عشر: باب الإنسان
- الباب الثالث عشر: باب الكون
- الباب الرابع عشر: باب الإجتماع
- الباب الخامس عشر: باب العلم
- الباب السادس عشر: باب الزمن
- الباب السابع عشر: باب التاريخ
- الباب الثامن عشر: باب الصحة
- الباب التاسع عشر: باب العسكرية
- الباب الاول : باب التوحيد
- الباب الثاني : باب النبوة
- الباب الثالث : باب الإمامة
- الباب الرابع : باب المعاد
- الباب الخامس: باب الإسلام
- الباب السادس : باب الملائكة
- تصنيف الصحيفة بالموضوعات
- أسماء الله الحسنى
- أعلام الهداية
- النبي محمد (صلى الله عليه وآله)
- الإمام علي بن أبي طالب (عليه السَّلام)
- السيدة فاطمة الزهراء (عليها السَّلام)
- الإمام الحسن بن علي (عليه السَّلام)
- الإمام الحسين بن علي (عليه السَّلام)
- لإمام علي بن الحسين (عليه السَّلام)
- الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السَّلام)
- الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السَّلام)
- الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السَّلام)
- الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السَّلام)
- الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السَّلام)
- الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السَّلام)
- الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السَّلام)
- الإمام محمد بن الحسن المهدي (عجَّل الله فرَجَه)
- تاريخ وسيرة
- "تحميل كتب بصيغة "بي دي أف
- تحميل كتب حول الأخلاق
- تحميل كتب حول الشيعة
- تحميل كتب حول الثقافة
- تحميل كتب الشهيد آية الله مطهري
- تحميل كتب التصنيف
- تحميل كتب التفسير
- تحميل كتب حول نهج البلاغة
- تحميل كتب حول الأسرة
- تحميل الصحيفة السجادية وتصنيفه
- تحميل كتب حول العقيدة
- قصص الأنبياء ، وقصص تربويَّة
- تحميل كتب السيرة النبوية والأئمة عليهم السلام
- تحميل كتب غلم الفقه والحديث
- تحميل كتب الوهابية وابن تيمية
- تحميل كتب حول التاريخ الإسلامي
- تحميل كتب أدب الطف
- تحميل كتب المجالس الحسينية
- تحميل كتب الركب الحسيني
- تحميل كتب دراسات وعلوم فرآنية
- تحميل كتب متنوعة
- تحميل كتب حول اليهود واليهودية والصهيونية
- المحقق جعفر السبحاني
- تحميل كتب اللغة العربية
- الفرقان في تفسير القرآن -الدكتور محمد الصادقي
- وقعة الجمل صفين والنهروان
|
|
سُورَة
النَّحلْ مكيّة وعَدَدُ آيَاتِها مَائة وَثمان وَعشرون آية
|
|
|
«سورة النحل» |
|
|
«سورة
النحل»محتويات السّورة:
|
|
|
يذهب أكثر المفسّرين إِلى أنّ قسماً من آيات هذه السورة مكيّة، وقسمها الآخر آيات مدنيّة،
في حين يعتبر بعضهم أنّ آياتها مكيةً على الإِطلاق. وعند ملاحظة طبيعة السورة المكية والمدنية يتبيّن لنا أنّ الرأي الأوّل أكثر صواباً، ويعزز ذلك ما تبحثه الآية (41) (والذين هاجروا في
اللّه...)، والآية (101) (ثمّ إنّ ربّك للذين
هاجروا من بعدما فتنوا ثمّ جاهدوا فصبروا...) حيث أنّها
تناولت بوضوح موضوع الهجرة والجهاد معاً.. وكما
هو بيّن فإِنّ الموضوعين يتناسبان مع الحوادث التي
جرت بعد هجرة النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من مكّة إلى المدينة. |
|
|
فضيلة
السّورة:
|
|
|
روي عن النّبي(صلى
الله عليه وآله وسلم)، في فضل سورة النحل، أنّه قال: «مَنْ قرأها لم يحاسبه
اللّه تعالى بالنعم التي أنعمها عليه من دار الدنيا»( مجمع البيان، ج6، ص327.). |
|
|
الآيتان(1) (2) أَتَى
أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهَ سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
|
|
|
أَتَى أَمْرُ
اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهَ سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(1)
يُنَزِّلُ الْمَلئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لآَ إِلهَ إِلآَّ أَنَا فَاتَّقُونِ(2) |
|
|
التّفسير |
|
|
أتى
أمْرُ اللَّهِ:
|
|
|
ذكرنا سابقاً أن قسماً مهمّاً
من الآيات التي جاءت في أوّل السورة هي آيات مكّية نزلت حينما كان النّبي(ص)
يخوض صراعاً مشتداً مع المشركين وعبدة الأصنام، وما يمر يوم حتى يطلع أعداء
الرسالة بمواجهة جديدة ضد الدعوة الإِسلامية المباركة، لأنّها تريد بناء صرح
الحرية، بل كل الحياة من جديد. |
|
|
الآيات(3) (8) خَلَقَ
السَّمَوتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
|
|
|
خَلَقَ السَّمَوتِ
وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(3)خَلَقَ الإِْنسنَ مِن
نُّطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ(4) وَالأَْنْعمَ خَلَقَها لَكُمْ فِيهَا
دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَد لَّمْ
تَكُونُوا بلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَْنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ(7)وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(8) |
|
|
التّفسير |
|
|
الحيوان
ذلك المخلوق المعطاء:
|
|
|
بعد أنْ تحدثت الآيات السابقة
عن نفي الشرك، جاءت هذه الآيات لتقلع جذوره بالكامل، وتوجه الإِنسان نحو خالقة
بطريقين: |
الآيات(9) (13)
وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَو شَآءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ
|
|
|
وَعَلَى اللّهِ
قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَو شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(9)
هُوَ الَّذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ
شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ(10) يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ
وَالنَّخِيلَ وَالأَْعْنبَ وَمِن كُلِّ الَّثمَرتِ إِنَّ فِى ذلِكَ لأَيَةً
لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ(11) وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرتٌ بُأَمْرِهِ إِنَّ فِى ذلِكَ لأََيت لِّقَوم
يَعْقِلُونَ(12)وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِى الأَْرضِ مُخْتَلِفاً أَلْونُهُ إِنَّ
فِى ذلِكَ لأََيَةً لِّقَوْم يَذَّكَّرونَ(13) |
|
|
التّفسير |
|
|
|
كل
شيء في خدمة الإِنسان!
|
|
|
بعد ذكر مختلف النعم في الآيات
السابقة، تشير هذه الآيات إلى نعم أُخرى... فتشير أوّلاً إِلى نعمة معنوية
عاليةً في مرماها (وعلى اللّه قصد السبيل) أيْ عليه سبحانه سلامة الصراط
المستقيم وهو الحافظ له من كل انحراف، وقد وضعه في متناول الإِنسان. |
|
|
توضيح:
|
|
|
جهّزَ اللَّهُ الإَنسان بقوى
متنوعة وأعطاه من القوى والقابليات المختلفة ما يعينه على سلوكه نحو الكمال الذي
هو الهدف من خلقه. |
|
|
البحوث
|
|
|
1 ـ النعم
المادية والمعنوية
|
|
|
احتوت الآيات مورد البحث على
ذكر النعم المادية والمعنوية بشكل مترابط لا يقبل الفصل، إِلاّ أن أُسلوب ولحن
التعبير يختلف بين النعم المادية والمعنوية، فبالنسبة للنعم المادية لا نجد
مورداً يقول فيه القرآن الكريم: إِنّ على اللّه رزقكم، لكنّه في مورد الهداية
يقول: (على اللّه قصد السبيل) فيعطيكم كل ما تحتاجونه تكوينياً وتشريعياً للسير
باقتدار في الطريق الإِلهي. وحينما يتحدث عن خلق الأشجار
والفواكه وعن تسخير الشمس والقمر نراه سبحانه يضعها في مسير هدف معنوي... (إِنّ في ذلك لآية لقوم يتفكرون) وذلك لإنّ الأُسلوب
القرآني ـ كما هو معروف ـ لا يتخذ بُعداً واحداً في خطابه للناس. |
|
|
2 ـ لماذا
الزّيتون والنخيل والأعناب دون غيرها؟!
|
|
|
يمكننا للوهلة الأُولى أن
نتصور أنّ ذكر القرآن للزيتون والتمر والعنب، في الآيات مورد البحث، لوجودها في
المنطقة التي نزل فيها القرآن.. ولكنْ بملاحظة الجانب العالمي لرسالة القرآن ومع
الإِعتقاد ببقائها واستمرارها بالإِضافة إِلى التوجه لعمق التعبير القرآني..
يتّضح لنا خطل ذلك التصور. |
|
|
3
ـ التفكر والتعقل والتذكر:
|
|
|
رأينا في الآيات
المبحوثة أنّ القرآن دعا الناس بعد ذكر
ثلاثة أقسام من النعم الإِلهية إِلى التأمل في ذلك، فقال في المورد الأوّل:
(إِن في ذلك لآية لقوم يتفكرون)، وفي المورد
الثّاني: (لقوم يعقلون) وفي الثّالث: (لقوم يذّكرون). |
الآيات(14) (18) وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيَّاً
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
|
|
|
وَهُوَ الَّذِى
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيَّاً وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(14) وَأَلْقَى فِى
الأََرْضِ رَوسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهراً وَسُبُلا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ(15) وَعَلَمَت وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ(16) أَفَمَن يَخْلُقُ
كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ(17) وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(18) |
|
|
التّفسير |
|
نعمة الجبال والبحار والنجوم:
|
|
|
|
تبيّن هذه الآيات قسماً آخر من النعم الإِلهية غير المحدودة التي تفضل
بها اللّه عزَّوجلّ على الإِنسان، فيبدأ القرآن الكريم بذكر البحار، المنبع
الحيوي للحياة، فيقول: (وهو الذي سخر البحر). وبلا شك، يلعب هذا البعد
دوراً مهمّاً في حياة البشر، وينبغي العمل على إِشباعه بشكل صحيح وسالم بعيداً
عن أي نوع من الإِفراط والتفريط.. والثابت في ا لواقع النفسي
للإِنسان، أن التعليم والتربية السليمة يستلزمان بذل أقصى سعي ممكن لإِقناع
المقابل بقبول ما يوجه إِليه عن قناعة ذاتية، أي ينبغي إِشعاره بأن ما يعطى إليه
ما هو في حقيقته إلاّ انبعاث من داخله وليس فرضاً عليه من الخارج ليتقبلها بكل
وجوده ويتبناها ويدافع عنها. |
|
|
بحث
|
|
|
الطريق ، العلامة ، القائد:
|
|
|
تحدثت الآيات أعلاه عن الطرق
الأرضية بكونها إحدى النعم الإِلهية باعتبارها من أهم وسائل الإِرتباط في طريق
التمدن الإِنساني. |
|
|
الآيات(19) (23)
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ
|
|
|
وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ(19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ(20) أَمْوتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ(21) إِلهُكُمْ إِلَهٌ وحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ
يُؤْمِنُونَ بِالأَْخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ(22)
لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ
يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ(23) |
|
|
التّفسير |
|
|
آلهة لا تشعر!
|
|
|
تناولت الآيات السابقة ذكر
صفتين ربانيتين لا تنطبق أية منها على الأصنام وسائر المعبودات الأُخرى غير
اللّه تعالى وهما: (خلق الموجودات، إِعطاء النعم)، أمّا الآية الأُولى أعلاه
فتشير إِلى الصفة الثّالثة للمعبود الحقيقي (وهي العلم)، فتقول: (واللّه يعلم ما تسرون وما يعلنون). |
|
|
بحث
|
|
|
من هم المستكبرون؟
|
|
|
وردت كلمة الإِستكبار في آيات
كثيرة من القرآن الكريم باعتبارها إِحدى الصفات الذميمة الخاصّة بالكفار، ولتعطي
معنى التكبر عن قبول الحق. |
|
|
الآيات(24) (29)
وَإِذا قِيلَ لَهُم مَّاذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَطِيرُ الأَْوَّلِينَ
|
|
|
وَإِذا قِيلَ لَهُم
مَّاذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَطِيرُ الأَْوَّلِينَ(24)لِيَحْمِلُوا
أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْم أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ(25) قَدْ مَكَرَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْينَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ
عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ
يَشْعُرُونَ(26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ
شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشقُّونَ فِيِهمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكفِرِينَ(27)
الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِى أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا
السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(28) فَادْخُلُوا أَبْوبَ جَهَنَّمَ خلِدِينَ فِيهَا
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ(29) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
جاء في تفسير مجمع
البيان: يروى أنّها نزلت في المقتسمين
وهم ستة عشر رجلا خرجوا إِلى عقاب مكّة أيام الحج على طريق الناس على كل
عقبة أربعة منهم ليصدوا الناس عن النّبي(ص) وإِذا سألهم الناس عمّا أنزل على
رسول اللّه(ص) قالوا: أحاديث الأولين وأباطيلهم. |
|
|
التّفسير |
|
|
حمل أوزار الآخرين:
|
|
|
دار الحديث في الآيات السابقة
حول عناد المستكبرين واستكبارهم أمام الحق، وسعيهم الحثيث في التنصل عن
المسؤولية وعدم التسليم للحق. |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ السُنّة سنتان.. حسنة وسيئة:
|
|
|
القيام بأي عمل يحتاج بلا شك
إِلى مقدمات كثيرة، وتعتبر السنن السائدة في المجتمع سواء كانت حسنة أم سيئة من
ممهدات الأرضية الفكرية والإِجتماعية التي تساعد القائد (سواء كان مرشداً أم
مضلا) للقيام بدوره بكل فاعلية، وحتى أنّه قد يفوق دور الموجهين وواضعي السنن
على جميع العاملين في بضع الأحيان. |
|
|
الآيات(30) (32)
وَقِيلَ لَلَّذِينَ اتَّقَوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً
لِّلَّذِينَ أحْسَنُوا
|
|
|
وَقِيلَ لَلَّذِينَ
اتَّقَوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِّلَّذِينَ أحْسَنُوا فِى
هذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الأَْخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ(30) جَنَّتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
الأَْنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذلِكَ يَجْزِى اللَّهُ
الْمُتَّقِينَ(31) الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(32) |
|
|
التّفسير |
|
|
عاقبة المتقين والمحسنين:
|
|
|
قرأنا في الآيات السابقه أقول
المشركين حول القرآن وعاقبة ذلك، والآن فندخل مع المؤمنين في اعتقادهم وعاقبته..
فيقول القرآن: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا
خيراً). ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل
اللّه عليه الخير والهدى. |
|
|
الآيات(33) (37) هَلْ
يَنظُرونَ إِلآَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَو يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
|
|
|
هَلْ يَنظُرونَ
إِلآَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَو يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِن كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ
بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهزِءُونَ(34) وقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ
شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء نَّحْنُ وَلآَ ءَابَاؤُنَا
وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء كَذْلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلَغُ الْمُبِينُ(35) وَلَقَدْ
بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّة رَّسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِى الأَْرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ (36) إِن تَحْرِصْ عَلَى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِى
مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ(37) |
|
|
التّفسير |
|
|
البلاغ المبين.. وظيفة الأنبياء:
|
|
|
يعود القرآن الكريم مرّة
أُخرى ليعرض لنا واقع وأفكار المشركين والمستكبرين ويقول بلهجة وعيد وتهديد:
ماذا ينتظرون؟ (هل ينظرون إِلاّ أن تأتيهم الملائكة) أي ملائكة الموت فتغلق
أبواب التوبة أمامهم حيث لا سبيل للرجوع بعد إِغلاق صحائف الأعمال! والآية (79) من
سورة النساء تشير إِلى المعنى المذكور
بقولها: (ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة
فمن نفسك). |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ ما هو البلاغ المبين؟
|
|
|
رأينا في الآيات مورد البحث
أنّ الوظيفة الرئيسية للأنبياء هي البلاغ المبين (فهل على الرسل إِلاّ البلاغ
المبين). |
|
|
2
ـ لكل أُمّة رسول
|
|
|
عند قوله عزَّ وجلّ: (ولقد بعثنا في كل أُمة رسول) يواجهنا السؤال التالي:
لو كان لكل أُمّة رسول لظهر الأنبياء في جميع مناطق العالم، ولكنّ التأريخ لا
يحكي لنا ذلك، فيكف التوجيه؟! كانوا يصلون إِليها وبوصولهم
يصل صوت رسول اللّه(ص) إِليها أسماع الجميع، بالإِضافة إِلى كتبه ورسائله
العديدة التي أرسلها إِلى الدول المختلفة (إِيران، الروم، الحبشة) ليبلغهم
الرسالة الإِلهية). |
|
|
الآيات(38) (40)
وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ
بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقَّاً
|
|
|
وَأَقْسَمُوا
بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْداً
عَلَيْهِ حَقَّاً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ(38) لِيُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
كَانُوا كَذِبِينَ(39)إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْء إِذَا أَرَدْنهُ أَن نَّقُولَ
لَهُ كُن فَيَكُونُ(40) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
ذكر المفسّرون في
شأن نزول الآية الأُولى (الآية 38) أنّ رجلا من المسلمين كان له دين على مشرك فتقاضاه فكان تتعلل في بتسديده،
فتأثر المسلم بذلك، فوقع في كلامه القسم بيوم القيامة وقال: والذي أرجوه بعد
الموت إنّه لكذا، فقال المشرك: وإِنّك لتزعم أنّك تبعث بعد الموت وأقسم باللّه،
لا يبعث اللّه مَنْ يموت. فأنزل اللّه الآية(مجمع
البيان، ذيل الآية مورد البحث.). |
|
|
التّفسير |
|
|
المعادو .. نهاية الإِختلافات:
|
|
|
تعرض الآيات أعلاه جانباً من
موضوع «المعاد» تكميلا لما بحث في الآيات السابقة ضمن موضوع التوحيد ورسالة
الأنبياء. وثمّة آيات قرآنية كثيرة كررت
مسألة أنّ اللّه عزَّ وجلّ سيحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون(راجع الآيات: (55) آل عمران، (48) المائدة، (164) الأنعام،
(92) النحل و(69) الحج.). |
|
|
الآيتان(41) (42)
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
فِى الْدُّنْيَا حَسَنَةً
|
|
|
وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى
الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لأََجْرُ الأَْخِرَةِ أَكْبَرُ لَو كَانُوا
يَعْلَمُونَ(41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(42) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
ذكر بعض المفسّرين
في شأن نزول الآية الأُولى (41): نزلت في
المعذبين بمكّة مثل صهيب وعمار وبلال وخباب وغيرهم مكّنهم اللّه في المدينة،
وذكر أن صهيباً قال لأهل مكّة: أنا رجل كبير إِن كنت معكم لم أنفعكم وإِن كنت
عليكم لم أضركم فخذوا مالي ودعوني، فأعطاهم ماله وهاجر إِلى رسول اللّه(صلى الله
عليه وآله وسلم) فقال له أحدهم: ربح البيع يا صهيب. |
|
|
التّفسير |
|
|
ثواب المهاجرين:
|
|
|
قلنا مراراً: إِنّ القرآن
الكريم يستخدم أُسلوب المقايسة والمقارنة كأهم أُسلوب للتربية والتوجيه، فما
يريد أن يعرضه للناس يطرح معه ما يقابله لتتشخص الفروق ويستوعب الناس معناه بشكل
أكثر وضوحاً. |
|
|
بحوث
|
|
|
1 ـ كما هو معروف فإِنّ للمسلمين هجرتين، الأُولى: كانت محدودة نسبياً (هجرة جمع من المسلمين
على رأسهم جعفر بن أبي طالب إِلى الحبشة)، والثّانية:
الهجرة العامة للنّبي(ص) والمسلمين من مكّة إِلى المدينة. |
|
|
الآيتان(43) (44)
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ
|
|
|
وَمَا أَرْسَلْنَا
مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(43) بِالْبَيِّنتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرونَ(44) |
|
|
التّفسير |
|
|
اِسألوا إِن كنتم لا تعلمون!
|
|
|
بعد أنْ عرض القرآن في
الآيتين السابقتين حال المهاجرين في سياق حديثه عن المشركين، يعود إِلى بيان
المسائل السابقة فيما يتعلق بأُصول الدين من خلال إِجابته لأحد الإِشكالات
المعروفة; حين يتقول المشركون: لماذا لم ينزل اللّه ملائكة لإِبلاغ رسالته؟ ...
أو يقولون: لِمَ لَمْ يجهز النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بقدرة خارقة ليجبرنا
على ترك أعمالنا!؟.. |
|
|
بحث
|
|
|
من هم أهل الذكر؟
|
|
|
ذكرت الرّوايات الكثيرة
المروية عن أهل البيت(عليهم السلام) أنّ «أهل الذكر» هم الأئمّة المعصومون(ع)،
ومن هذه الرّوايات: |
|
|
الآيات(45) (47)
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الأَْرْضَ أَوْ يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ
|
|
|
أَفَأَمِنَ
الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَْرْضَ أَوْ
يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيَشْعُرُونَ(45) أَو يأخُذَهُمْ فِى
تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ(46) أَوْ يَأخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّف
فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ(47) |
|
|
التّفسير |
|
|
لكلِّ ذنب عقابه:
|
|
|
ثمّة ربط في كثير من بحوث
القرآن بين الوسائل الإِستدلالية والمسائل الوجدانية بشكل مؤثر في نفوس
السامعين، والآيات أعلاه نموذج لهذا الأُسلوب. «مكروا
السيئات»: بمعنى وضعوا الدسائس والخطط
وصولا لأهدافهم المشؤمة السيئة، كما فعل المشركون للنيل من نور القرآن ومحاولة
قتل النّبي(ص)وما مارسوه من إِيذاء وتعذيب للمؤمنين المخلصين. |
|
|
الآيات(48) (50) أَوَ
لَمْ يَرَوْا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْء يَتَفَيَّؤُا ظِلَلُهُ عَنِ
الَْيمِينِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّداً لَّلَّهِ
|
|
|
أَوَ لَمْ يَرَوْا
مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْء يَتَفَيَّؤُا ظِلَلُهُ عَنِ الَْيمِينِ
وَالشَّمَآئِلِ سُجَّداً لَّلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ(48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا
فِى السَّموتِ وَمَا فِى الأَْرْضَ مِن دَابَّة وَالْمَلئِكَةُ وَهُمْ
لاَيَسْتَكْبِرُونَ(49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُون(50) |
|
|
التّفسير |
|
|
سجود الكائنات للّه عزَّ وجلّ:
|
|
|
تعود هذه الآيات مرّة أُخرى
إِلى التوحيد بادئةً بـ: (أوَلم يروا إِلى ما خلق اللّه
من شيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سُجّداً للّه وهم داخرون)( داخر: في
الأصل من مادة (دخور) أيْ: التواضع.). |
|
|
الآيات(51) (55)
وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلهَيْنَ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ وحِدٌ
فَإِيَّىَ فَارْهَبُونِ
|
|
|
وَقَالَ اللَّهُ
لاَ تَتَّخِذُوا إِلهَيْنَ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ وحِدٌ فَإِيَّىَ
فَارْهَبُونِ(51) وَلَهُ مَا فِى السَّمَوتِ وَالأَْرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ(52) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَة فَمِنَ
اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُون(53) ثُمَّ إِذا
كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ(54)
لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(55) |
|
|
التّفسير |
|
|
دين حق ومعبود واحد:
|
|
|
تتناول هذه الآيات موضوع نفي
الشرك تعقيباً لبحث التوحيد ومعرفة اللّه عن طريق نظام الخلق الذي ورد في الآيات
السابقة، لتتّضح الحقيقة من خلال المقارنة بين الموضوع، ويبتدأ بـ: (وقال اللّه
لا تتخذوا إِلهين اثنين إنّما هو إِله واحد فإِيّاي فارهبون). فعندما يثبت أن عالم الوجود
منه، وهو الذي أوجد جميع قوانينه التكوينية فينبغي أن تكون القوانين التشريعية
من وضعه أيضاً، ولا تكون طاعة إِلاّ له سبحانه. |
|
|
الآيات(56) (60)
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَيَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنهُمْ تَاللَّهِ
لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
|
|
|
وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لاَيَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ
عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ(56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنتِ سُبْحنَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ(57) وَإِذابُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُْنثى ظَلَّ
وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ(58) يَتَورَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرابِ أَلاَ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ(59) لِلَّذِينَ لاَيُؤمِنُونَ بِالأَْخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَى وَهُوَ الْعَزِيَزُ الْحَكِيمُ(60) |
|
|
التّفسير |
|
|
عندما كانت ولادة البنت عاراً!
|
|
|
بعد أن عرضت الآيات السابقة
بحوثاً استدلالية في نفي الشرك وعبادة الأصنام، تأتي هذه الآيات لتتناول قسماً
من بدع المشركين وصوراً من عاداتهم القبيحة، لتضيف دليلا آخراً على بطلان الشرك
وعبادة الأصنام، فتشير الآيات إِلى ثلاثة أنواع من بدع وعادات المشركين: وتقول أوّلاً: (ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً ممّا رزقناهم)( ذكر المفسّرون
رأيين في تفسير «ما لا يعلمون» وضميرها: |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ لماذا اعتبروا الملائكة بناتاً لله؟
|
|
|
تطالعنا الكثير من آيات
القرآن الكريم بأنّ المشركين كانوا يقولون بأنّ الملائكة بنات اللّه جلّ وعلا،
أو أنّهم كانوا يعتبرون الملائكة إِناثاً دون نسبتها إِلى اللّه.. يمكن أن تكون هذه الإِعتقادات
بقايا خرافات الأقوام السابقة التي وصلت عرب الجاهلية، أو ربما يحصل هذا الوهم
بسبب ستر الملائكة عنهم وحال الإِستتار أكثر ما يختص بحال النساء، ولهذا تعتبر
العرب الشمس مؤنثاً مجازياً والقمر مذكراً مجازياً أيضاً، على اعتبار أنّ قرص
الشمس لا يمكن للناظر إِليه أن يديم النظر لأنه يستر نفسه بقوة نوره، أمّا قرص
القمر فظاهر للعين ويسمح للنظر إِليه مهما طالت المدّة. |
|
|
2 ـ لماذا شاع وأد البنات في
الجاهلية؟
|
|
|
الوأد في واقعه أمرٌ رهيب،
لأنّ الفاعل يقوم بسحق كل ما بين جوانحه من عطف ورحمة، ليتمكن من قتل إِنسان
بريء ربّما هو من أقرب الأشياء إِليه من نفسه! (قاموس
الرجال، ج5، ص 125 (مضموناً).) |
|
|
3
ـ دور الإِسلام في إِعادة اعتبار المرأة:
|
|
|
لم يكن احتقار المرأة مختصاً
بعرب الجاهلية، فلم تلق المرأة أدنى درجات الإِحترام والتقدير حتى في أكثر
الأُمم تمدناً في ذلك الزمان، وكانت المرأة غالباً ما يتعامل معها باعتبارها
بضاعة وليست إِنساناً محترماً، ولكنّ عرب الجاهلية جسدوا تحقير المرأة بأشكال
أكثر قباحة ووحشية من غيرهم، حتى أنّهم ما كانوا يدخلونهن في الأنساب كما نقرأ ذلك في الشعر الجاهلي المعروف: |
|
|
الآيات(61) (64)
وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن
دَابَّة
|
|
|
وَلَوْ يُؤاخِذُ
اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة وَلكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّىً فَإِذا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ
يَسْتَئْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ(61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا
يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى
لاَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ(62) تَاللَّهِ لَقَدْ
أَرْسَلنَا إِلى أُمَم مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْملَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ(63) وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتبَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً
وَرَحْمَةً لِقَوم يُؤْمِنُونَ(64) |
|
|
التّفسير |
|
|
وسعت رحمته غضبه:
|
|
|
بعد أن تحدثت الآيات السابقة
عن جرائم المشركين البشعة في وأدهم للبنات، يطرق بعض الأذهان السؤال التالي:
لماذا لم يعذب اللّه المذنبين بسرعة نتيجة لما قاموا به من فعل قبيح وظلم فجيع؟! والآية الأُولى
(61) تجيب بالقول: (ولو يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم ما ترك
عليها من دابة)( ـ إِن ضمير «عليها» يعود إِلى «الأرض»
وإِنْ لم يرد لها ذكر في الآيات المتقدمة لوضوح الأمر، ونظائر ذلك كثيرة في لغة
العرب.). |
|
|
بحث
|
|
|
ما هو الأجل المسمى؟
|
|
|
للمفسّرين بيانات
كثيرة بشأن المراد من «الأجل المسمى» ولكن بملاحظة سائر الآيات
القرآنية، ومن جملتها الآية (2) من سورة الأنعام،
والآية (34) من سورة الأعراف، يبدو أنّ المراد منه وقت حلول الموت، أيْ:
إِنَّ اللّه عزَّوجلّ يمهل الناس إِلى آخر عمرهم المقرر لهم إِتماماً للحجة
عليهم، ولعل مَنْ ظلم يعود إِلى رشده ويصلح شأنه فيكون ذلك العود سبباً لرجوعه إِلى
بارئه الحق وإِلى العدالة. واحتمل بعض
المفسّرين أيضاً أنّ «الحسنى»
تعني نعمة الأولاد الذكور، لأنّهم يعتبرون البنات سوءاً وشرّاً، والبنين نعمةً
وحسنى. ولهذا.. (ولهم عذاب
أليم). |
|
|
الآيات(65) (67)
وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمآءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا
|
|
|
وَاللَّهُ أَنْزَلَ
مِنَ السَّمآءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِى
ذلِكَ لأََيَةً لِقَوْم يَسْمَعُونَ(65) وَإِنَّ لَكُمْ فِى الأَْنْعمِ
لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْث وَدَم لَّبَناً
خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّرِبِينَ(66) وَمِن ثَمَرتِ النَّخِيلِ وَالأَْعْنبِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إَنَّ فِى ذلِكَ لأََيَةً
لِقَوْم يَعْقِلُونَ(67) |
|
|
التّفسير |
|
|
المياه، الثمار، الأنعام:
|
|
|
مرّة أُخرى، يستعرض القرآن
الكريم النعم والعطايا الإِلهية الكثيرة، تأكيداً لمسألة التوحيد ومعرفة اللّه،
وإِشارة إِلى مسألة المعاد، وتحريكاً لحس الشكر لدى العباد ليتقربوا إِليه
سبحانه أكثر، ومن خلال هذا التوجيه الرّباني تتّضح علاقة الربط بين هذه الآيات
وما سبقها من آيات. |
|
|
بحوث : كيف يتكوّن اللبن؟ أهم ما في اللبن من مواد غذائية غذاء
خالص وسهل الهضم
|
|
|
1 ـ
كيف يتكوّن اللبن؟ يقول القرآن الكريم في ذلك
كما في الآيات أعلاه: إنّه يخرج من بين «فرث» ـ الأغذية
المهضومة داخل المعدة ـ و «دم». أمّا سكر اللاكتوز
الموجود في اللبن فيؤخذ من السكر
الموجود في الدم بعد أن تجري عليه الغدد الخاصّة في الثدي التغييرات اللازمة
لتحويله إِلى نوع جديد من السكر. |
|
|
الآيتان(68) (69)
وَأَوْحى رَبُّكَ إِلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَاً
وَمِنَ الشَّجَرِ
|
|
|
وَأَوْحى رَبُّكَ
إِلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَاً وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ(68) ثمّ كُلِى مِن كُلِّ الَّثمَرتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ
رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِن بُطُونِها شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْونُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (69) |
|
|
التّفسير |
|
|
(وأوحى
ربّك إِلى النحل)!
|
|
|
انتقل الأسلوب القرآني بهاتين
الآيتين من عرض النعم الإِلهية المختلفة وبيان أسرار الخليقة إِلى الحديث عن
«النحل» وما يدره من منتوج (العسل) ورمز إِلى ذلك الالهام الخفي بالوحي الإِلهي
إِلى النحل: (أن اتّخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر
وممّا يعرشون). |
|
|
1
ـ ما هو «الوحي»
|
|
|
«الوحي» في
الإصل (كما يقول الراغب في مفرداته) بمعنى
الإِشارة السريعة، ثمّ بمعنى الالقاء الخفى. |
|
|
2
ـ هل يختص الإِلهام الغريزي بالنحل؟
|
|
|
وإِذا كان وجود الغرائز
(الإِلهام الغريزي) غير منحصر بالنحل دون جميع الحيوانات، فلماذا ورد ذكره في
الآية في النحل خاصّة؟ |
|
|
3 ـ المهمّة
الأُولى في حياة النحل:
|
|
|
وأوّل مهمّة أمر بها النحل في
هذه الآية هي: بناء البيت، ولعل ذلك إِشارة إِلى أن اتّخاذ المسكن المناسب
بمثابة الشرط الأوّل للحياة، ومن ثمّ القيام ببقية الفعاليات، أو لعله إِشارة
إِلى ما في بيوت النحل من دقة ومتانة، حيث أن بناء البيوت الشمعية والسداسية
الأضلاع، والتي كانت منذ ملايين السنين وفي أماكن متعددة ومختلفة، قد يكون أعجب
حتى من عمليه صنع العسل(عُرِفَ لحد الآن (4500) نوعاً
من النحل الوحشي، والعجيب أنّها في حال واحدة من حيث: الهجرة، بناء الخلايا،
المكان، تناول رحيق الأزهار، أوّل جامعة، الجزء الخامس.). |
|
|
4
ـ اين مكان النحل:
|
|
|
وقد عيّنت الآية المباركة
مكان بناء الخلايا في الجبال، وبين الصخور وانعطافاتها المناسبة، وبين أغصان
الإشجار، وأحياناً في البيوت التي يصنعها لها الإِنسان. |
|
|
بحوث قيمة: مم يتكون العسل، أين يصنع العسل؟ ،ألوانه، عجائب حياة النحل
|
|
|
وفي الآية جملة
بحوث قيمة أُخرى: 3 ـ
أين يصنع العسل؟ 5 ـ
العسل .. والشفاء من الأمراض: ويقول العلماء: لا ينبغي حفظ العسل في أواني فلزية. 8 ـ
عجائب حياة النحل إِنّ روح الخلية تأمر النحل
المهندس والبناء والعامل ببناء البيوت، وهي التي تأمر سكنة المدينة جميعاً
بالهجرة منها في يوم معين وساعة معينة، وتتجه نحو حوادث ومشاق غير معلومة من أجل
تحصيل مسكن ومأوى جديد! |
|
|
الآيات(70) (72)
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُم وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلى
أَرْذَلِ الْعُمُرِ
|
|
|
وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُم وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَىْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ(70) وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِى الرَّزْقِ فَمَا
الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ(71) وَاللَّهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبتِ أَفَبِالْبطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ(72) |
|
|
التّفسير |
|
|
سبب اختلاف الأرزاق:
|
|
|
بيّنت الآيات السابقة قسماً
من النعم الإِلهية المجعولة في عالمي النبات والحيوان، لتكون دليلا حسياً
لمعرفته جل شأنه، وتواصل هذه الآيات مسألة إِثبات الخالق جل وعلا بأسلوب آخر،
وذلك بأن تغيير النعم خارج عن اختيار الإِنسان، وذلك كاشف بقليل من الدقة
والتأمل على وجود المقدّر لذلك. فيبتدأ القول بـ
(واللّه خلقكم ثمّ يتوفاكم). |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ أسباب الرزق:
|
|
|
على الرغم ممّا ذكر بخصوص
التفاوت من حيث الإِستعداد والمواهب عند الناس، إِلاّ أنّ أساس النجاح يمكن في
السعي والمثابرة والجد، فالأكثر سعياً أكثر نجاحاً في الحياة والعكس صحيح. |
|
|
2
ـ مواساة الآخرين:
|
|
|
أشارت الآيات إِلى بخل كثير
من الناس ممن لم يتّبعوا سلوك وهدي الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)، وقد أكّدت
الرّوايات في تفسيرها لهذه الآيات على المساواة والمواساة ومنها: ما جاء في
تفسير علي بن إِبراهيم في ذيل الآية: «لا يجوز الرجل أن يخص نفسه بشيء من
المأكول دون عياله»( تفسير نور الثقلين، ج3، ص68.). |
|
|
الآيتان(73) (74)
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ
السَّمواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً
|
|
|
وَيَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً
وَلاَ يَسْتَطِيعُون(73) فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهَ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(74) |
|
|
التّفسير |
|
|
لا تجعلوا لله شبيهاً:
|
|
|
تواصل هاتان
الآيتان بحوث التوحيد السابقة، وتشير
إِلى موضوع الشرك، وتقول بلهجة شديدة ملؤها اللوم والتوبيخ: (ويعبدون من دون اللّه ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات
والأرض شيئاً). |
|
|
الآيات(75) (77)
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَمَنْ
رَّزَقْنهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً
|
|
|
ضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَمَنْ رَّزَقْنهُ مِنَّا
رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَووُنَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(75) وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَهُوَ كَلٌّ
عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَما يُوَجِّههُّ لاَيَأْتِ بِخَيْر هَلْ يَسْتَوِى هُوَ
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرط مُّسْتَقِيم(76) وَلِلِّهِ غَيْبُ
السَّموتِ وَالأَْرْضِ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَو
هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ(77) |
|
|
التّفسير |
|
|
مثلان للمؤمن والكافر!
|
|
|
ضمن التعقيب على الآيات
السابقة التي تحدثت عن: الإِيمان، الفكر، المؤمنين، الكافرين والمشركين، تشخص
الآيات مورد البحث حال المجموعتين (المؤمنين والكافرين) بضرب مثلين حيين وواضحين
يشبه المثال الأوّل المشركين بعبد مملوك لا يستطيع القيام بأية خدمة لمولاه،
ويشبه المؤمنين بإِنسان غني، يستفيد الجميع من إِمكانياته.. (ضرب اللّه مثلا
عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء). وبعبارة مختصرة
تجيب الآية على كل أبعاد السؤال، فالله
عزَّوجلّ «يعلم غيب السماوات والأرض» فهو حاضر في كل زمان ومكان، وعليه فلا يخفى
عليه شيء أبداً، ولا مفهوم لقولهم إِطلاقاً، وكل شيء يعلمه تعالى شهوداً، وأمّا
تلك العبارات والأحوال فإِنّما تناسب وجودنا الناقص لا غير. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ الإِنسان بين الحرية والأسر
|
|
|
إِنّ مسألة التوحيد والشرك
ليست مسألة عقائدية ذهنية صرفة كما يتوهم البعض وذلك لما لها من آثار بالغة على
كافة أصعدة الحياة، بل وأنّ بصماتها لتراها شاخصة على كافة مرافق ومناحي الحياة
ـ فالتوحيد إِذا دخل قلباً أحياه وغرس فيه عوامل الرّشد والكمال، لانّه بتوسيع
أفق نظر وتفكير الإِنسان بشكل يجعله مرتبطاً بالمطلق. |
|
|
2
ـ دور العدل والإِستقامة في حياة الإِنسان
|
|
|
من الملفت للنظر إِشارة
الآيات إِلى الدعوة للعدل والسير على الصراط المستقيم من بين صفات وشوؤن
الموحدين، لتبيان ما لهذين الأمرين من أهمية في خصوص الوصول إِلى المجتمع
الإِنساني السعيد، وهو ما يتم من خلال امتلاك برنامج صحيح بعيد عن أي انحراف
يميناً أو شمالا (لا شرقي ولا غربي)، ومن ثمّ الدعوة لتنفيذ ذلك البرنامج المبني
على أُصول العدل، كما وينبغي أن لا يكون البرنامج وقتياً ينتهي بانقضاء المدّة،
بل كما يقول القرآن: (يأمر بالعدل) (حيث يعطي الفعل المضارع معنى الإِستمرار)
برنامج مستمر ودائمي. |
|
|
3
ـ أمّا الرّوايات الواردة عن أهل البيت(عليهم السلام)
|
|
|
الرّوايات الواردة عن أهل
البيت(عليهم السلام) بخصوص تفسير هذه الآية تذكر أنّ: «الذي يأمر بالعدل أمير
المؤمنين والأئمّة صلوات اللّه عليهم»( نور الثقلين،
ج3، ص70.). |
|
|
الآيات(78) (83)
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهتِكُمْ لاَتَعْلَمُونَ شَيْئاً
|
|
|
وَاللَّهُ
أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهتِكُمْ لاَتَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالأَْبْصرَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ
يَرَوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرت فِى جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فِى ذلِكَ لأََيت لَّقَوْم يُؤْمِنُونَ(79) وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ
الأَْنْعمِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم
وَمَنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثثاً وَمَتعاً إِلى
حِين(80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِللا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ
الْجِبَالِ أَكْنَناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَربِيلَ تَقِبكُمُ الْحَرَّ وَسَربِيلَ
تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذلك يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْلِمُونَ(81) فإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلغُ المُبِينُ(82)
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَها وَأَكثَرُهُمُ الْكفِرُونَ (83) |
|
|
التّفسير |
|
|
أنواع النعم المادية والمعنوية:
|
|
|
يعود القرآن الكريم مرّة
أُخرى بعرض جملة أُخرى من النعم الإِلهية كدرس في التوحيد ومعرفة اللّه، وأوّل
ما يشير في هذه الآيات المباركات إِلى نعمة العلم والمعرفة ووسائل تحصيله..
ويقول: (واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئاً). |
|
|
ملاحظات
|
|
|
1
ـ بداية الإِدراك عند الإِنسان
|
|
|
وهنا نطرح
الملاحظات التالية: |
|
|
2
ـ نعمة وسائل المعرفة
|
|
|
ممّا لا شك فيه عدم امكانية
استيعاب ودخول العالم الخارجي في وجودنا، والحاصل الفعلي هو رسم صورة الشيء
الخارجي المراد في الذهن وبواسطة الوسائل المعينة لذلك، وعليه.. فمعرفتنا بالعالم
الخارجي تكون عن طريق أجهزة خاصّة منها السمع والبصر. ونشاهد تقديم ذكر السمع على
البصر في الآية مع ما للعين من عمل أوسع من السمع، ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل
على العين بعد الولادة، حيث أنّ العين كانت في ظلام دامس (في رحم الأم) ونتيجة
لشدّة أشعة النّور (بعد الولادة) فإِنّها لا تستطيع العمل مباشرة بسبب حساسيتها،
وإِنّما تتدرج في اعتيادها على مواجهة النّور حتى تصل للحالة الطبيعية المعتادة،
ولذا نجد الوليد في بداية أيّامه الأُولى مغلق العين. أمّا بخصوص الأذن.. فثمة
مَنْ يعتقد بأنّ لها القدرة على السماع (قليلا أو كثيراً) وهي في عالم الأجنّة
وأنّها تسمع دقات قلب الأم وتعتاد عليها! |
|
|
3
ـ لعلكم تشكرون
|
|
|
تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم
من أفضل النعم التي وهبها اللّه للإِنسان، فلا يقتصر دور العين والأذن (مثلا)
على النظر إِلى آثار اللّه في خلقه، والإِستماع إِلى أحاديث أنبياء اللّه
وأوليائه، وتفهم ذلك وتدركه بالتحليل والإِستنتاج، بل إِنّ كل خطوة نحو التكامل
والتقدم مرتبطة إِرتباطاً وثيقاً بهذه الوسائل الثلاثة. |
|
|
بحوث
|
|
|
1 ـ أسرار تحليق
الطيور في السماء
|
|
|
إِنّنا لا نشعر بأهمية الكثير
من عجائب عالم الوجود لاعتيادنا على كثرة مشاهدتها ولعدم انشغالنا بالتدقيق
العلمي عند المشاهدة، حتى باتت هذه العادة كحجاب يغطي تلك العظمة، ولو استطاع
أيٍّ منّا رفع ذلك الحجاب عن ذهنه لرأى العجائب الكثيرة من حوله. |
|
|
2
ـ ترابط الآيات:
|
|
|
لا شك أنّ هناك ترابطاً بين
الآية أعلاه والتي تتحدث عن كيفية طيران الطيور وما قبلها من الآيات يتمثل في
الحديث عن نعم اللّه عزَّ وجلّ في عالم الخليقة، وعن أبعاد عظمته وقدرته سبحانه
وتعالى، ولكن لا يبعد أن يكون ذكر تحليق الطيور بعد ذكر آلات المعرفة يحمل بين
طياته إِشارة لطيفة في تشبيه تحليق هذه الطيور في العالم المحسوس بتحليق الأفكار
في العالم غير المحسوس، فكلُّ منها يحلق في فضائه الخاص وبما لديه من آلات. |
|
|
3
- الظلال، المساكن، الأغطية:
|
|
|
ويشير القرآن الكريم إِلى نعمة أُخرى بقوله: (واللّه
جعل لكم ممّا خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناناً). «الأكنان»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطية والحفظ، ولهذا فقد أُطلقت
على المغارات وأماكن الإِختفاء وفي الجبال. ويشاهد في القرآن الكريم
مقاطع قرآنية تطلق الكفر على ذلك النوع الناشىء من التكّبر والعناد، ومنها ما
يتحدث عن الشيطان كما جاء في الآية (34) من سورة البقرة
(أبى واستكبر وكان من الكافرين). |
|
|
بحثان: 1 ـ كلمات المفسّرين، 2 ـ صراع الحقّ مع الباطل
|
|
|
1 ـ
كلمات المفسّرين |
|
|
الآيات(84) (89)
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيداً ثُمَّ لاَيُؤْذَنُ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
|
|
|
وَيَوْمَ نَبْعَثُ
مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيداً ثُمَّ لاَيُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ(84) وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ(85) وَإِذا رَءَا الَّذِينَ
أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤُلاءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ
كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكذِبُونَ(86) وَأَلْقَوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم
مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ(87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
زِدْنهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ(88) وَيَوْمَ
نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّة شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجئْنا بِكَ
شَهِيداً عَلَى هَؤُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتبَ تِبْيناً لِّكُلِّ
شَىْء وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(89) |
|
|
التّفسير |
|
|
عندما
تغلق الأبواب أمام المجرمين:
|
|
|
بعد أن عرض القرآن الكريم في
الآيات السابقة جحود منكري الحق وعدم اعترافهم بالنعم الإِلهية، يتطرق في هذه
الآيات إِلى جانب من العقاب الإِلهي الشديد الذي ينتظر أُولئك في عالم الآخرة،
لينبه الغافل من سباته، فعسى أنْ يعيد النظر في مواقفه المنحرفة قبل فوات
الأوان، فيقول أوّلاً: (ويوم نبعث من كل أُمّة شهيداً)(
ألـ «يوم» هنا ظرفٌ متعلق بفعل مقدّر، وأصل العبارة: (وليذكروا) أو (واذكروا).). وعندها... تبدأ تلك الأصنام
بالتكلم (بإِذن اللّه): (فألقوا إِليهم القول إِنّكم لكاذبون)، فلم نكن شركاء
لله، ومهما وسوسنا لكم فلا نستحق حمل بعض أوزاركم. 4 ـ لعل ورود
جملة (فألقوا إِليهم القول) بدل «قالوا لهم» لعدم قدرة الأصنام على التكلم
بنفسها، فيكون قولها عبارة عن إِلقاء من قبل اللّه فيها، أيْ أنّ اللّه عزَّوجلّ
يلقي إِليها، وهي بدورها تلقية إِلى المشركين. |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ القرآن تبيان لكل شيء:
|
|
|
من أهم ما تطرقت له الآيات
المباركات هو أنّ القرآن مبين لكل شيء. |
|
|
2
ـ مراحل الهداية الأربع
|
|
|
إِنّ الآية أعلاه
ذكرت أربعة تعابير متلازمة حسب تسلسلها لتوضيح الهدف من نزول القرآن: |
|
|
الآية(90) إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسنِ وَإِيتَآىءِ ذِى الْقُرْبى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ
|
|
|
إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسنِ وَإِيتَآىءِ ذِى الْقُرْبى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ وَالْبَغِى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(90) |
|
|
التّفسير |
|
|
أكمل برنامج إِجتماعي:
|
|
|
بعد أن ذكرت الآيات السابقة
أنّ القرآن فيه تبيان لكل شيء، جاءت هذه الآية المباركة لتقدم نموذجاً من
التعليمات الإِسلامية في شأن المسائل الإِجتماعية والإِنسانية والأخلاقية، وقد
تضمّنت الآية ستة أُصول مهمّة، الثلاث الأوّل منها ذات طبيعة إِيجابية ومأمور
بالعمل بها، والبقية ذات صفة سلبية منهي عن ارتكابها. |
|
|
الآيات(91) (94)
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عهَدتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمنَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
|
|
|
وَأَوْفُوا
بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عهَدتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمنَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ(91) وَلاَتَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّة أَنكَثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ
تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمَّة إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ(92) وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وحِدَةً وَلكِن
يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ(93)وَلاَتَتَّخِذُوا أَيْمنَكُمْ دَخَلاًَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ
قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
يقول المفسّر
الكبير العلاّمة الطبرسي في (مجمع البيان) في شأن نزول أوّل آية من هذه الآيات أنّها نزلت في الذين بايعوا النّبي(ص)
على الإِسلام (وكان من المحتمل أن ينقض بعضهم البيعة لقلّة المسلمين وكثرة
الأعداء)، فقال سبحانه مخاطباً لهم لا يحملنّكم قلّة المسلمين وكثرة المشركين
على نقض البيعة). |
|
|
التّفسير |
|
|
الوفاء بالعهد دليل الإِيمان:
|
|
|
بعد أن عرض القرآن الكريم في
الآية السابقة بعض أصول الإِسلام الأساسية (العدل، والإِحسان، وما شابههما)،
يتناول في هذه الآيات قسماً آخر من تعاليم الإِسلام المهمّة (الوفاء بالعهد
والأيمان). |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ فلسفة احترام العهد
|
|
|
كما هو معلوم فإِنّ الثقة
المتبادلة بين أفراد المجتمع تمثل أهم دعائم رسوخ المجتمع، بل من دعائم تشكيل
المجتمع وإِخراجه من حالة الآحاد المتفرقة وإِعطائه صفة التجمع، وبالإِضافة لكون
أصل الثقة المتبادلة يعتبر السند القويم للقيام بالفعاليات الإِجتماعية والتعاون
على مستوى واسع. |
|
|
2
ـ ما لا يقبل في نقض العهود:
|
|
|
إِنّ قبح نقض العهد الشناعة
بحيث لا احداً على استعداد لأن يتحمل مسؤوليته بصراحة إلاّ النادر من الناس حتى
أن ناقض العهد يلتمس لذلك اعذاراً وتبريرات مهما كانت واهية لتبرير فعلته. وقد
ذكرت لنا الآيات أعلاه نموذجاً لذلك.. فبعض المسلمين يتذرعون بحجج واهية ككثرة
الأعداء وقلة المؤمنين للتنصل من عهودهم مع اللّه والنّبي(ص) فتكون مواقفهم
متزلزلة، في حين أنّ الأكثرية من حيث العدد لا تمثل القدرة والقوة في واقع
الحال، وانتصار القلّة المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة من الشواهد المعروفة في
تأريخ البشرية، ثمّ إِنّ حصول القدرة والقوة للأعداء ـ على فرض حصولها ـ لا تسوغ
لأن تكون مبرراً مقبولا لنقض العهد، ولو دققنا النظر في الإمر لرأينا في واقعه
أنّه نوع من الشرك والجهل باللّه عزَّوجلّ. |
|
|
الآيات(95) (97) وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
|
|
|
وَلاَ تَشْتَرُوا
بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(95) مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ(96)مَنْ عَمِلَ صلِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(97) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
نقل المفسّر الكبير
العلاّمة الطبرسي عن ابن عباس قوله: إِنّ رجلا من حضرموت يقال له عيدان الأشرع قال: يا رسول اللّه، إِنّ امرأ
القيس الكندي جاورني في أرضي فاقتطع من أرضي فذهب بها منّي، والقوم يعلمون إِنّي
لصادق، ولكنّه أكرم عليهم منّي، فسأل رسول اللّه اُمرأ القيس عنه فقال: لا أدري
ما يقول، فأمره أنْ يحلف. فقال عيدان: إِنّه فاجر لا يبالي أنْ يحلف، فقال: إِنْ
لم يكن لك شهود فخذ بيمينه، فلماذا قام ليحلف أنظره فانصر فافنزل قوله:
(ولاتشتروا وابعهد اللّه...) الآيتان فلمّا قرأهما رسول اللّه(صلى الله عليه
وآله وسلم)قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي فينفد وهو صادق فيما يقول، لقد اقتطعت
أرضه ولم أدرِ كم هي، فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما أكلت من ثمرها،
فنزل فيه (مَنْ عمل صالحاً...)الآية. |
|
|
التّفسير |
|
|
ثمن الحياة الطيبة:
|
|
|
جاءت الآية الأُولى من هذه الآيات لتؤكّد على قبح نقض العهد مرّة أُخرى
ولتبيّن عذراً آخراً من أعذار نقض العهد الواهية، فحيث تطرقت الآيات السابقة
إِلى عذر الخوف من كثرة الأعداء تأتي هذه الآية لتطرح ما للمصلحة الشخصية
(المادية) من أثر سلبي على حياة الإِنسان. ولا تخلو جملة (ولنجزين الذين صبروا...) من الإِشارة إِلى أنّ الصبر
والثبات في السير على طريق الطاعة، وخصوصاً حفظ العهود والإِيمان هي من أفضل
أعمال الإِنسان. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ منابع الخلود
|
|
|
إِنّ طبيعة الحياة في هذا
العالم المادي هي الفناء والهلاك، فأقوى الأبنية وأكثر الحكومات دواماً وأشد
البشر قدرة لا يعدون أن يصيروا في نهاية أمرهم إِلى الضعف فالفناء، وكل شيء معرض
للتلف بلا استثناء في هذا الأمر. |
|
|
2
ـ التساوي بين الرجل والمرأة
|
|
|
ممّا لا شك فيه أنّ بين الرجل
والمرأة تفاوت واختلاف من الناحيتين الجسمية والروحية، وهذا الفرق هو الذي
جعلهما مختلفين في وظائفها وشؤونهما الإِجتماعية، إِلاّ أنّ طبيعة الإِختلاف
الموجود لا تنعكس على الشخصية الإِنسانية، ولا توجد اختلافاً في مقامهما عند
اللّه عزَّوجلّ، فهما في هذا الجانب متساويان ومتكافئان، ويحكم شخصية أي منهما
مقياس واحد ألا وهو الإِيمان والعمل الصالح والتقوى، وإِمكانية تحصيل ذلك لأيٍّ
منهما متساوية. |
|
|
3 ـ جذور العمل
الصالح ترتوي من الإِيمان
|
|
|
العمل الصالح: مصطلح له من سعة المفهوم ما يضم بين طياته جميع الأعمال
الإِيجابية والمفيدة والبناءة على كافة أصعدة الحياة العلمية والثقافية
والإِقتصادية والسياسية والعسكرية...الخ. |
|
|
4
ـ ما هي الحياة الطيبة؟
|
|
|
لقد ذكر المفسّرون في معنى
الحياة الطيبة تفاسير عديدة: وبملاحظة تعبير الآية عن
الجزاء الإِلهي وفق أحسن الأعمال، ليفهم من ذلك أنّ الحياة الطيبة ترتبط بعالم
الدنيا بينما يرتبط الجزاء بالأحسن بعالم الآخرة. |
|
|
الآيات(98) (100) فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطنِ الْرَّجِيمَ
|
|
|
فَإِذا قَرَأْتَ
الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطنِ الْرَّجِيمَ(98)إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوَا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ(99) إِنَّمَا سُلْطنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ
وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ(100) |
|
|
التّفسير |
|
|
إِقرأ
القرآن هكذا:
|
|
|
لم يفت ذاكرتنا ما ورد قبل
عدّة آيات أنّ القرآن (تبياناً لكل شيء) ثمّ تمّ البحث عن قسم من أهم الأوامر
الإِلهية في القرآن. |
|
|
بحوث
|
|
|
1 ـ موانع
المعرفة
|
|
|
مع كل ما للحقيقة من ظهور
ووضوح فإِنّها لا تلحظ إِلاّ بعين باصرة، وبعبارة أُخرى، ثمة شرطان لمعرفة
الحقائق: لأنّه قد أوجد الأحكام
المسبقة الخاطئة عنده، وسمح للأهواء النفسية والتعصبات العمياء المتطرفة أن
تتغلب على توجهه، ووقع في أسر الذات والغرور، ولوث صفاء قلبه وطهارة روحه بأُمور
قد جعلها موانع أمام فهم وإِدراك الحقائق. |
|
|
2
ـ لماذا يكون التعوذ «من الشيطان الرجيم»؟
|
|
|
«الرجيم»: من
(رجم)، بمعنى الطرد، وهو في الأصل بمعنى الرمي بالحجر ثمّ استعمل في الطرد. ونلاحظ ذكر صفة طرد
الشيطان من دون جميع صفاته، للتذكير بتكبّره
على أمر اللّه حين أمره بالسجود والخضوع لآدم، وإِنّ ذلك التكبّر الذي دخل
الشيطان بات بمثابة حجاب بينه وبين إِدراك الحقائق، حتى سولت له نفسه أن يعتقد
بأفضليته على آدم وقال: (أنا خير منه خلقتني من نار
وخلقته من طين). |
|
|
3 ـ بين لوائي
الحقّ والباطل
|
|
|
قسمت الآيات أعلاه الناس إِلى
قسمين: قسم يرزح تحت سلطة الشيطان وقسم خارج عن هذه السلطة، وبيّنت صفتين لكلٍّ
من هذين القسمين: |
|
|
4
ـ آداب تلاوة القرآن:
|
|
|
كل شيء يحتاج الى برنامج معين
ولا يستثنى كتاب عظيم ـ كالقرآن الكريم ـ من هذه القاعدة، لذلك فقد ذكر في
القرآن بعض الآداب والشروط لتلاوة كلام اللّه والإِستفادة من آياته: |
|
|
الآيات(101) (105)
وَإِذا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر
|
|
|
وَإِذا بَدَّلْنَا
ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا
أَنْتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ
الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدىً
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَمِىٌّ
وَهَذا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ(103) إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ
بِأَيتِ اللَّهِ لاَيَهْدِيِهمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(104) إِنَّمَا
يَفْتَرِى الكَذِبَ الَّذِينَ لاَيؤْمِنُونَ بِأَيتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكذِبُونَ(105) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
يقول ابن عباس: (كانوا يقولون: يسخر محمّد بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر
وغداً يأمرهم بأمر، وإِنّه لكاذب، يأتيهم بما يقول من عند نفسه). |
|
|
التّفسير |
|
|
الإِفتراء!
|
|
|
تحدثت الآيات السابقة أُسلوب
الإِستفادة من القرآن الكريم، وتتناول الآيات مورد البحث جوانب أُخرى من المسائل
المرتبطة بالقرآن، وتبتدىء ببعض الشبهات التي كانت عالقة في أذهان المشركين حول
الآيات القرآنية المباركة، فتقول: (وإِذا بدّلنا آية
مكان آية واللّه أعلم بما ينزّل) فهذا التغيير والتبديل يخضع لحكمة
اللّه، فهو أعلم بما ينزل، وكيف ينزل، ولكن المشركين لجهلهم (قالوا إِنّما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون). وبعد الإِجابة على
هذه الأسئلة لا يبقى لنا إِلاّ أنْ نقول: ليس النسخ سوى
برنامج مؤقت في مراحل إِنتقالية. نعم، فمع كل ما وصلت إِليه
البشرية من قوانين وأنظمة ما زال القرآن هو المتفوق وسيبقى. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ قبح الكذب في المنظور الإِسلامي
|
|
|
الآية الأخيرة بحثت مسألة قبح
الكذب بشكل عنيف، وقد جعلت الكاذبين بدرجة الكافرين والمنكرين للآيات الإِلهية. |
|
|
2
ـ الكذب منشأ جميع الذنوب:
|
|
|
وقد اعتبرت الأحاديث الشريفة
الكذب مفتاح الذنوب.. |
|
|
3
ـ الكذب منشأ للنفاق:
|
|
|
لأنّ الصدق يعني تطابق اللسان
مع القلب، في حين أن الكذب يعني عدم تطابق اللسان مع القلب، وما النفاق إِلاّ
الإِختلاف بين الظاهر والباطن. |
|
|
4
ـ لا انسجام بين الكذب والإِيمان:
|
|
|
وإِضافة إِلى الآية المباركة
فثمة أحاديث كثيرة تعكس لنا هذه الحقيقة الجليّة... |
|
|
5
ـ الكذب يرفع الإِطمئنان:
|
|
|
إِنّ وجود الثقة والإِطمئنان
المتبادل من أهم ما يربط الناس فيما بينهم، والكذب من الأُمور المؤثرة في تفكيك
هذه الرابطة لما يشيعه من خيانة وتقلب، ولذلك كان تأكيد الإِسلام على أهمية
الإِلتزام بالصدق وترك الكذب. |
|
|
الآيات(106)
(111) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمنِ
|
|
|
مَن كَفَرَ
بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالإِيمنِ وَلكِنَ مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا
الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الأَْخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِى الْقَومَ
الْكَفِرِينَ(107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ
وَأَبْصرِهِمْ وَأُلَئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ(108) لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى
الأَْخِرَةِ هُمُ الْخسِرُونَ(109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
مِن بَعْدِ مَافُتِنُوا ثمّ جهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(110) يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نِفْس تُجدِلُ عَن نَّفْسِهَا
وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ(111) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
ذكر بعض المفسّرون في شأن نزول الآية الأُولى من هذه الآيات أنّها: نزلت في
جماعة أُكرهوا ـ وهو: عمار وأبوه ياسر وأُمّة سمية
وصهيب وبلال وخبّاب ـ عُذِّبُوا وقُتِل أبو عمار وأَمّه وأعطاهم عمار
بلسانه ما أرادوا منه، ثمّ أخبر سبحانه بذلك رسوله(ص)، فقال قوم: كفر عمّار.
فقال(ص) كلا: «إِنّ عماراً مليء إِيماناً من قرنه إِلى قدمه واختلط الإيمان
بلحمه دمه».. وجاء عمّار إِلى رسول اللّه وهو يبكي، فقال النّبي(ص): «ما وراءك»؟
فقال: شرّ يا رسول اللّه، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسول
اللّه(ص) يمسح عينيه ويقول: «إِنْ عادوا لك فعد لهم بما قلت»، فنزلت الآية. |
|
|
التّفسير |
|
|
المرتدون عن الإِسلام:
|
|
|
تكمل هذه الآيات ما شرعت به
الآيات السابقة من الحديث عن المشركين والكفار وما كانوا يقومون به، فتتناول الآيات فئة أُخرى من الكفرة وهم المرتدون. |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ التقية وفلسفتها:
|
|
|
إِمتاز المسلمون الأوائل
الذين تربّوا على يد النّبي(ص) بروح مُقاومة عظيمة أمام أعدائهم، وسجل لنا
التأريخ صوراً فريدة للصمود والتحدي، وها هو «ياسر» لم يلن ولم يدخل حتى الغبطة
الكاذبة على شفاه الأعداء، وما تلفظ حتى بعبارة خالية من أيّ أثر على قلبه ممّا
يطمح الأعداء أن يسمعوها منه، مع أنّ قلبه مملوءاً ولاءً وإِيماناً بالله تعالى
وحبّاً وإِخلاصاً للنّبي(ص) وصبر على حاله رغم مرارتها فنال شرف الشهادة، ورحلت
روحه الطاهرة إِلى بارئها صابرة محتسبة تشكو إليه ظلم وجور أعداء دين اللّه. |
|
|
2
ـ المرتد الفطري والملي و.. المخدوعين:
|
|
|
لايواجه الإِسلام الذين لا
يعتنقون الإِسلام من (أهل الكتاب) بالشدّة والقسوة وإِنّما يدعوهم باستمرار
ويتحدث معهم بالمنطق السليم، فإِذا لم يقتنعوا وراموا البقاء على ديانتهم فيعطون
الأمان والتعهد بحفظ أموالهم وأرواحهم ومصالحهم المشروعة بعد أن يعلنوا قبول شرط
أهل الذمة في عهدهم مع المسلمين. |
|
|
الآيات(112) (114) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً
مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَان
|
|
|
وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً
مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ(112) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ
رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فأخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظلِمُونَ(113)
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَللا طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
إِن كُنْتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ(114) |
|
|
التّفسير |
|
|
الذين كفروا فأصابهم العذاب
|
|
|
قلنا مراراً: إِنّ هذه السورة
هي سورة النِعَمْ، النعم المادية والمعنوية وعلى كافة الأصعدة، وقد مرَّ ذكر في
آيات متعددة من هذه السورة المباركة. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ أهو مثالٌ أمْ حدثٌ تاريخي؟
|
|
|
لقد عبّرت الآيات أعلاه عند
حديثها عن تلك المنطقة العامرّة بكثرة النعم، والتي أصاب أهلها بلاء الجوع
والخوف نتيجة كفرهم بأنعم اللّه، عبّرت عن ذلك بكلمة «مثلا» وبذات الوقت فإِنّ
الآية استخدمت الأفعال بصيغة الماضي، ممّا يشير إِلى وقوع ما حدث فعلا في زمن
ماض، وهنا حصل اختلاف بين المفسّرين في الهدف من البيان القرآني، فقسمٌ قد احتمل
أنّ الهدف هو ضرب مثال عام، وذهب القسم الثّاني إِلى أنّه لبيان واقعة تأريخية معيّنة. |
|
|
2
ـ الرابطة ما بين الأمن والرّزق الكثير
|
|
|
ذكرت الآيات ثلاث
خصائص لهذه المنطقة العامرّة المباركة: |
|
|
3
ـ لباس الجوع والخوف
|
|
|
ذكرت الآيات في بيان عاقبة
الكافرين بنعم اللّه، قائلةً: (فأذاقها اللّه لباس الجوع والخوف) فمن جهة: شبّهت
الجوع والخوف باللباس، ومن جهة أُخرى: عبّرت بـ «أذاقها» بدلا من (ألبسها). |
|
|
4
ـ أثر كفران النعمة في تضييع المواهب الإِلهية
|
|
|
رأينا في الرّواية المتقدمة
كيف راح أُولئك المرفهون بتطهير أجسادهم بواسطة المواد الغذائية بعد أنْ تسلطت
عليهم الغفلة وساورهم الغرور، حتى ابتلاهم اللّه بالقحط والخوف. |
|
|
الآيات(115) (119) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنزِيِر وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
|
|
|
إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيِر وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ(115)وَلاَ تَقَولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَللٌ
وَهذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ(116) مَتعٌ قَلِيلٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا
قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبلُ وَمَا ظَلَمْنهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ(118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهلَة ثُمَّ
تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ(119) |
|
|
التّفسير |
|
|
لا يفلح الكاذبون:
|
|
|
بعد أنْ تحدثت الآيات السابقة
عن النعم الإِلهية ومسألة شكر النعمة، تأتي الآيات أعلاه لتتحدث عن آخر حلقات
الموضوع وتطرح مسألة المحرمات الواقعية وغير الواقعية لتفصل بين الدين الحق وبين
البدع التي أُحدثت في دين اللّه، وتشرع بالقول: (إِنّما حرّم عليكم الميتة
والدّم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لغير اللّه به)(
أُهِلَّ: من الإِهلال، مأخوذُ من الهلال، بمعنى إِعلاء الصوت عند رؤية الهلال،
وباعتبار أنّ المشركين كانوا إِذا ذبحوا حيواناتهم للأصنام صرخوا عالياً بأسماء
أصنامهم، فقد عبّر عنه بـ «أُهِلَّ».). |
|
|
الآيات(120) (124) إِنَّ إِبْرهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ
حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِينَ
|
|
|
إِنَّ إِبْرهِيمَ
كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْركِينَ(120)شَاكِراً لأَِنْعُمِهِ اجْتَبهُ وَهَدَاهُ إِلى صِراط
مُّسْتَقِيم(121) وءَاتَيْنهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى
الأَْخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ(122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(123) إِنَّمَا
جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَومَ الْقِيمَةِ فِيَما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(124) |
|
|
التّفسير |
|
|
كان إِبراهيم لوحده أُمّة!
|
|
|
كما قلنا مراراً بأنّ هذه
السورة هي سورة النعم، وهدفها تحريك حس الشكر لدى الإِنسان بشكل يدفعه لمعرفة
خالق وواهب هذه النعم. تساؤل: لماذا لم يحرم في الإِسلام ما كان محرماً في دين اليهود؟
فجاء الجواب أنّ ذلك كان عقاباً لهم، فيطرح السؤال مرّة أُخرى حول عدم حرمة صيد
الأسماك يوم السبت في الأحكام الإِسلامية في حين أنّه محرم على اليهود ..فيكون
الجواب بأنّه كان عقاباً لليهود أيضاً. |
|
|
الآيات(125) (128) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ
|
|
|
ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خيْرٌ للِّصَّبِرِينَ (126)
وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ
فِى ضَيْق مَمَّا يَمْكُرُونَ(127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا
وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ(128) |
|
|
التّفسير |
|
|
عشرة قواعد أخلاقية .. سلاحٌ
داعية الحق: 4 ـ
إِنصب الحديث في الأصول الثلاثة حول البحث المنطقي والأُسلوب العاطفي والمناقشة
المعقولة مع المخالفين، وإِذا حصلت
المواجهة معهم ولم يتقبلوا الحق وراحوا يعتدون، فهنا يأتي الأصل الرابع: (وإِنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). 12
ـ (ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات). 34
ـ (واللّه جعل لكم من بيوتكم سكناً) وهي البيوت الثابتة. وبعد الإِشارة إِلى إِكمال النعم الإِلهية، تقول الآية (81): (لعلّكم تسلمون). |
|
|
|
|
|

|
|
سُورَة
النَّحلْ مكيّة وعَدَدُ آيَاتِها مَائة وَثمان وَعشرون آية
|
|
|
«سورة النحل» |
|
|
«سورة
النحل»محتويات السّورة:
|
|
|
يذهب أكثر المفسّرين إِلى أنّ قسماً من آيات هذه السورة مكيّة، وقسمها الآخر آيات مدنيّة،
في حين يعتبر بعضهم أنّ آياتها مكيةً على الإِطلاق. وعند ملاحظة طبيعة السورة المكية والمدنية يتبيّن لنا أنّ الرأي الأوّل أكثر صواباً، ويعزز ذلك ما تبحثه الآية (41) (والذين هاجروا في
اللّه...)، والآية (101) (ثمّ إنّ ربّك للذين
هاجروا من بعدما فتنوا ثمّ جاهدوا فصبروا...) حيث أنّها
تناولت بوضوح موضوع الهجرة والجهاد معاً.. وكما
هو بيّن فإِنّ الموضوعين يتناسبان مع الحوادث التي
جرت بعد هجرة النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من مكّة إلى المدينة. |
|
|
فضيلة
السّورة:
|
|
|
روي عن النّبي(صلى
الله عليه وآله وسلم)، في فضل سورة النحل، أنّه قال: «مَنْ قرأها لم يحاسبه
اللّه تعالى بالنعم التي أنعمها عليه من دار الدنيا»( مجمع البيان، ج6، ص327.). |
|
|
الآيتان(1) (2) أَتَى
أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهَ سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
|
|
|
أَتَى أَمْرُ
اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهَ سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(1)
يُنَزِّلُ الْمَلئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لآَ إِلهَ إِلآَّ أَنَا فَاتَّقُونِ(2) |
|
|
التّفسير |
|
|
أتى
أمْرُ اللَّهِ:
|
|
|
ذكرنا سابقاً أن قسماً مهمّاً
من الآيات التي جاءت في أوّل السورة هي آيات مكّية نزلت حينما كان النّبي(ص)
يخوض صراعاً مشتداً مع المشركين وعبدة الأصنام، وما يمر يوم حتى يطلع أعداء
الرسالة بمواجهة جديدة ضد الدعوة الإِسلامية المباركة، لأنّها تريد بناء صرح
الحرية، بل كل الحياة من جديد. |
|
|
الآيات(3) (8) خَلَقَ
السَّمَوتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
|
|
|
خَلَقَ السَّمَوتِ
وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(3)خَلَقَ الإِْنسنَ مِن
نُّطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ(4) وَالأَْنْعمَ خَلَقَها لَكُمْ فِيهَا
دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَد لَّمْ
تَكُونُوا بلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَْنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ(7)وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(8) |
|
|
التّفسير |
|
|
الحيوان
ذلك المخلوق المعطاء:
|
|
|
بعد أنْ تحدثت الآيات السابقة
عن نفي الشرك، جاءت هذه الآيات لتقلع جذوره بالكامل، وتوجه الإِنسان نحو خالقة
بطريقين: |
الآيات(9) (13)
وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَو شَآءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ
|
|
|
وَعَلَى اللّهِ
قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَو شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(9)
هُوَ الَّذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآء لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ
شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ(10) يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ
وَالنَّخِيلَ وَالأَْعْنبَ وَمِن كُلِّ الَّثمَرتِ إِنَّ فِى ذلِكَ لأَيَةً
لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ(11) وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرتٌ بُأَمْرِهِ إِنَّ فِى ذلِكَ لأََيت لِّقَوم
يَعْقِلُونَ(12)وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِى الأَْرضِ مُخْتَلِفاً أَلْونُهُ إِنَّ
فِى ذلِكَ لأََيَةً لِّقَوْم يَذَّكَّرونَ(13) |
|
|
التّفسير |
|
|
|
كل
شيء في خدمة الإِنسان!
|
|
|
بعد ذكر مختلف النعم في الآيات
السابقة، تشير هذه الآيات إلى نعم أُخرى... فتشير أوّلاً إِلى نعمة معنوية
عاليةً في مرماها (وعلى اللّه قصد السبيل) أيْ عليه سبحانه سلامة الصراط
المستقيم وهو الحافظ له من كل انحراف، وقد وضعه في متناول الإِنسان. |
|
|
توضيح:
|
|
|
جهّزَ اللَّهُ الإَنسان بقوى
متنوعة وأعطاه من القوى والقابليات المختلفة ما يعينه على سلوكه نحو الكمال الذي
هو الهدف من خلقه. |
|
|
البحوث
|
|
|
1 ـ النعم
المادية والمعنوية
|
|
|
احتوت الآيات مورد البحث على
ذكر النعم المادية والمعنوية بشكل مترابط لا يقبل الفصل، إِلاّ أن أُسلوب ولحن
التعبير يختلف بين النعم المادية والمعنوية، فبالنسبة للنعم المادية لا نجد
مورداً يقول فيه القرآن الكريم: إِنّ على اللّه رزقكم، لكنّه في مورد الهداية
يقول: (على اللّه قصد السبيل) فيعطيكم كل ما تحتاجونه تكوينياً وتشريعياً للسير
باقتدار في الطريق الإِلهي. وحينما يتحدث عن خلق الأشجار
والفواكه وعن تسخير الشمس والقمر نراه سبحانه يضعها في مسير هدف معنوي... (إِنّ في ذلك لآية لقوم يتفكرون) وذلك لإنّ الأُسلوب
القرآني ـ كما هو معروف ـ لا يتخذ بُعداً واحداً في خطابه للناس. |
|
|
2 ـ لماذا
الزّيتون والنخيل والأعناب دون غيرها؟!
|
|
|
يمكننا للوهلة الأُولى أن
نتصور أنّ ذكر القرآن للزيتون والتمر والعنب، في الآيات مورد البحث، لوجودها في
المنطقة التي نزل فيها القرآن.. ولكنْ بملاحظة الجانب العالمي لرسالة القرآن ومع
الإِعتقاد ببقائها واستمرارها بالإِضافة إِلى التوجه لعمق التعبير القرآني..
يتّضح لنا خطل ذلك التصور. |
|
|
3
ـ التفكر والتعقل والتذكر:
|
|
|
رأينا في الآيات
المبحوثة أنّ القرآن دعا الناس بعد ذكر
ثلاثة أقسام من النعم الإِلهية إِلى التأمل في ذلك، فقال في المورد الأوّل:
(إِن في ذلك لآية لقوم يتفكرون)، وفي المورد
الثّاني: (لقوم يعقلون) وفي الثّالث: (لقوم يذّكرون). |
الآيات(14) (18) وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيَّاً
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
|
|
|
وَهُوَ الَّذِى
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيَّاً وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(14) وَأَلْقَى فِى
الأََرْضِ رَوسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهراً وَسُبُلا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ(15) وَعَلَمَت وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ(16) أَفَمَن يَخْلُقُ
كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ(17) وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(18) |
|
|
التّفسير |
|
نعمة الجبال والبحار والنجوم:
|
|
|
|
تبيّن هذه الآيات قسماً آخر من النعم الإِلهية غير المحدودة التي تفضل
بها اللّه عزَّوجلّ على الإِنسان، فيبدأ القرآن الكريم بذكر البحار، المنبع
الحيوي للحياة، فيقول: (وهو الذي سخر البحر). وبلا شك، يلعب هذا البعد
دوراً مهمّاً في حياة البشر، وينبغي العمل على إِشباعه بشكل صحيح وسالم بعيداً
عن أي نوع من الإِفراط والتفريط.. والثابت في ا لواقع النفسي
للإِنسان، أن التعليم والتربية السليمة يستلزمان بذل أقصى سعي ممكن لإِقناع
المقابل بقبول ما يوجه إِليه عن قناعة ذاتية، أي ينبغي إِشعاره بأن ما يعطى إليه
ما هو في حقيقته إلاّ انبعاث من داخله وليس فرضاً عليه من الخارج ليتقبلها بكل
وجوده ويتبناها ويدافع عنها. |
|
|
بحث
|
|
|
الطريق ، العلامة ، القائد:
|
|
|
تحدثت الآيات أعلاه عن الطرق
الأرضية بكونها إحدى النعم الإِلهية باعتبارها من أهم وسائل الإِرتباط في طريق
التمدن الإِنساني. |
|
|
الآيات(19) (23)
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ
|
|
|
وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ(19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ(20) أَمْوتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ(21) إِلهُكُمْ إِلَهٌ وحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ
يُؤْمِنُونَ بِالأَْخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ(22)
لاَ جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ
يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ(23) |
|
|
التّفسير |
|
|
آلهة لا تشعر!
|
|
|
تناولت الآيات السابقة ذكر
صفتين ربانيتين لا تنطبق أية منها على الأصنام وسائر المعبودات الأُخرى غير
اللّه تعالى وهما: (خلق الموجودات، إِعطاء النعم)، أمّا الآية الأُولى أعلاه
فتشير إِلى الصفة الثّالثة للمعبود الحقيقي (وهي العلم)، فتقول: (واللّه يعلم ما تسرون وما يعلنون). |
|
|
بحث
|
|
|
من هم المستكبرون؟
|
|
|
وردت كلمة الإِستكبار في آيات
كثيرة من القرآن الكريم باعتبارها إِحدى الصفات الذميمة الخاصّة بالكفار، ولتعطي
معنى التكبر عن قبول الحق. |
|
|
الآيات(24) (29)
وَإِذا قِيلَ لَهُم مَّاذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَطِيرُ الأَْوَّلِينَ
|
|
|
وَإِذا قِيلَ لَهُم
مَّاذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَطِيرُ الأَْوَّلِينَ(24)لِيَحْمِلُوا
أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْم أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ(25) قَدْ مَكَرَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْينَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ
عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ
يَشْعُرُونَ(26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ
شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشقُّونَ فِيِهمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكفِرِينَ(27)
الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِى أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا
السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(28) فَادْخُلُوا أَبْوبَ جَهَنَّمَ خلِدِينَ فِيهَا
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ(29) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
جاء في تفسير مجمع
البيان: يروى أنّها نزلت في المقتسمين
وهم ستة عشر رجلا خرجوا إِلى عقاب مكّة أيام الحج على طريق الناس على كل
عقبة أربعة منهم ليصدوا الناس عن النّبي(ص) وإِذا سألهم الناس عمّا أنزل على
رسول اللّه(ص) قالوا: أحاديث الأولين وأباطيلهم. |
|
|
التّفسير |
|
|
حمل أوزار الآخرين:
|
|
|
دار الحديث في الآيات السابقة
حول عناد المستكبرين واستكبارهم أمام الحق، وسعيهم الحثيث في التنصل عن
المسؤولية وعدم التسليم للحق. |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ السُنّة سنتان.. حسنة وسيئة:
|
|
|
القيام بأي عمل يحتاج بلا شك
إِلى مقدمات كثيرة، وتعتبر السنن السائدة في المجتمع سواء كانت حسنة أم سيئة من
ممهدات الأرضية الفكرية والإِجتماعية التي تساعد القائد (سواء كان مرشداً أم
مضلا) للقيام بدوره بكل فاعلية، وحتى أنّه قد يفوق دور الموجهين وواضعي السنن
على جميع العاملين في بضع الأحيان. |
|
|
الآيات(30) (32)
وَقِيلَ لَلَّذِينَ اتَّقَوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً
لِّلَّذِينَ أحْسَنُوا
|
|
|
وَقِيلَ لَلَّذِينَ
اتَّقَوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِّلَّذِينَ أحْسَنُوا فِى
هذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الأَْخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ
الْمُتَّقِينَ(30) جَنَّتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
الأَْنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذلِكَ يَجْزِى اللَّهُ
الْمُتَّقِينَ(31) الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(32) |
|
|
التّفسير |
|
|
عاقبة المتقين والمحسنين:
|
|
|
قرأنا في الآيات السابقه أقول
المشركين حول القرآن وعاقبة ذلك، والآن فندخل مع المؤمنين في اعتقادهم وعاقبته..
فيقول القرآن: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا
خيراً). ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزل
اللّه عليه الخير والهدى. |
|
|
الآيات(33) (37) هَلْ
يَنظُرونَ إِلآَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَو يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
|
|
|
هَلْ يَنظُرونَ
إِلآَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَئِكَةُ أَو يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِن كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ
بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهزِءُونَ(34) وقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ
شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء نَّحْنُ وَلآَ ءَابَاؤُنَا
وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء كَذْلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلَغُ الْمُبِينُ(35) وَلَقَدْ
بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّة رَّسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِى الأَْرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ (36) إِن تَحْرِصْ عَلَى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِى
مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ(37) |
|
|
التّفسير |
|
|
البلاغ المبين.. وظيفة الأنبياء:
|
|
|
يعود القرآن الكريم مرّة
أُخرى ليعرض لنا واقع وأفكار المشركين والمستكبرين ويقول بلهجة وعيد وتهديد:
ماذا ينتظرون؟ (هل ينظرون إِلاّ أن تأتيهم الملائكة) أي ملائكة الموت فتغلق
أبواب التوبة أمامهم حيث لا سبيل للرجوع بعد إِغلاق صحائف الأعمال! والآية (79) من
سورة النساء تشير إِلى المعنى المذكور
بقولها: (ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة
فمن نفسك). |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ ما هو البلاغ المبين؟
|
|
|
رأينا في الآيات مورد البحث
أنّ الوظيفة الرئيسية للأنبياء هي البلاغ المبين (فهل على الرسل إِلاّ البلاغ
المبين). |
|
|
2
ـ لكل أُمّة رسول
|
|
|
عند قوله عزَّ وجلّ: (ولقد بعثنا في كل أُمة رسول) يواجهنا السؤال التالي:
لو كان لكل أُمّة رسول لظهر الأنبياء في جميع مناطق العالم، ولكنّ التأريخ لا
يحكي لنا ذلك، فيكف التوجيه؟! كانوا يصلون إِليها وبوصولهم
يصل صوت رسول اللّه(ص) إِليها أسماع الجميع، بالإِضافة إِلى كتبه ورسائله
العديدة التي أرسلها إِلى الدول المختلفة (إِيران، الروم، الحبشة) ليبلغهم
الرسالة الإِلهية). |
|
|
الآيات(38) (40)
وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ
بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقَّاً
|
|
|
وَأَقْسَمُوا
بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْداً
عَلَيْهِ حَقَّاً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ(38) لِيُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
كَانُوا كَذِبِينَ(39)إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْء إِذَا أَرَدْنهُ أَن نَّقُولَ
لَهُ كُن فَيَكُونُ(40) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
ذكر المفسّرون في
شأن نزول الآية الأُولى (الآية 38) أنّ رجلا من المسلمين كان له دين على مشرك فتقاضاه فكان تتعلل في بتسديده،
فتأثر المسلم بذلك، فوقع في كلامه القسم بيوم القيامة وقال: والذي أرجوه بعد
الموت إنّه لكذا، فقال المشرك: وإِنّك لتزعم أنّك تبعث بعد الموت وأقسم باللّه،
لا يبعث اللّه مَنْ يموت. فأنزل اللّه الآية(مجمع
البيان، ذيل الآية مورد البحث.). |
|
|
التّفسير |
|
|
المعادو .. نهاية الإِختلافات:
|
|
|
تعرض الآيات أعلاه جانباً من
موضوع «المعاد» تكميلا لما بحث في الآيات السابقة ضمن موضوع التوحيد ورسالة
الأنبياء. وثمّة آيات قرآنية كثيرة كررت
مسألة أنّ اللّه عزَّ وجلّ سيحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون(راجع الآيات: (55) آل عمران، (48) المائدة، (164) الأنعام،
(92) النحل و(69) الحج.). |
|
|
الآيتان(41) (42)
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
فِى الْدُّنْيَا حَسَنَةً
|
|
|
وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى
الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لأََجْرُ الأَْخِرَةِ أَكْبَرُ لَو كَانُوا
يَعْلَمُونَ(41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(42) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
ذكر بعض المفسّرين
في شأن نزول الآية الأُولى (41): نزلت في
المعذبين بمكّة مثل صهيب وعمار وبلال وخباب وغيرهم مكّنهم اللّه في المدينة،
وذكر أن صهيباً قال لأهل مكّة: أنا رجل كبير إِن كنت معكم لم أنفعكم وإِن كنت
عليكم لم أضركم فخذوا مالي ودعوني، فأعطاهم ماله وهاجر إِلى رسول اللّه(صلى الله
عليه وآله وسلم) فقال له أحدهم: ربح البيع يا صهيب. |
|
|
التّفسير |
|
|
ثواب المهاجرين:
|
|
|
قلنا مراراً: إِنّ القرآن
الكريم يستخدم أُسلوب المقايسة والمقارنة كأهم أُسلوب للتربية والتوجيه، فما
يريد أن يعرضه للناس يطرح معه ما يقابله لتتشخص الفروق ويستوعب الناس معناه بشكل
أكثر وضوحاً. |
|
|
بحوث
|
|
|
1 ـ كما هو معروف فإِنّ للمسلمين هجرتين، الأُولى: كانت محدودة نسبياً (هجرة جمع من المسلمين
على رأسهم جعفر بن أبي طالب إِلى الحبشة)، والثّانية:
الهجرة العامة للنّبي(ص) والمسلمين من مكّة إِلى المدينة. |
|
|
الآيتان(43) (44)
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ
|
|
|
وَمَا أَرْسَلْنَا
مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(43) بِالْبَيِّنتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرونَ(44) |
|
|
التّفسير |
|
|
اِسألوا إِن كنتم لا تعلمون!
|
|
|
بعد أنْ عرض القرآن في
الآيتين السابقتين حال المهاجرين في سياق حديثه عن المشركين، يعود إِلى بيان
المسائل السابقة فيما يتعلق بأُصول الدين من خلال إِجابته لأحد الإِشكالات
المعروفة; حين يتقول المشركون: لماذا لم ينزل اللّه ملائكة لإِبلاغ رسالته؟ ...
أو يقولون: لِمَ لَمْ يجهز النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بقدرة خارقة ليجبرنا
على ترك أعمالنا!؟.. |
|
|
بحث
|
|
|
من هم أهل الذكر؟
|
|
|
ذكرت الرّوايات الكثيرة
المروية عن أهل البيت(عليهم السلام) أنّ «أهل الذكر» هم الأئمّة المعصومون(ع)،
ومن هذه الرّوايات: |
|
|
الآيات(45) (47)
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الأَْرْضَ أَوْ يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ
|
|
|
أَفَأَمِنَ
الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَْرْضَ أَوْ
يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيَشْعُرُونَ(45) أَو يأخُذَهُمْ فِى
تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ(46) أَوْ يَأخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّف
فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ(47) |
|
|
التّفسير |
|
|
لكلِّ ذنب عقابه:
|
|
|
ثمّة ربط في كثير من بحوث
القرآن بين الوسائل الإِستدلالية والمسائل الوجدانية بشكل مؤثر في نفوس
السامعين، والآيات أعلاه نموذج لهذا الأُسلوب. «مكروا
السيئات»: بمعنى وضعوا الدسائس والخطط
وصولا لأهدافهم المشؤمة السيئة، كما فعل المشركون للنيل من نور القرآن ومحاولة
قتل النّبي(ص)وما مارسوه من إِيذاء وتعذيب للمؤمنين المخلصين. |
|
|
الآيات(48) (50) أَوَ
لَمْ يَرَوْا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْء يَتَفَيَّؤُا ظِلَلُهُ عَنِ
الَْيمِينِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّداً لَّلَّهِ
|
|
|
أَوَ لَمْ يَرَوْا
مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْء يَتَفَيَّؤُا ظِلَلُهُ عَنِ الَْيمِينِ
وَالشَّمَآئِلِ سُجَّداً لَّلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ(48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا
فِى السَّموتِ وَمَا فِى الأَْرْضَ مِن دَابَّة وَالْمَلئِكَةُ وَهُمْ
لاَيَسْتَكْبِرُونَ(49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُون(50) |
|
|
التّفسير |
|
|
سجود الكائنات للّه عزَّ وجلّ:
|
|
|
تعود هذه الآيات مرّة أُخرى
إِلى التوحيد بادئةً بـ: (أوَلم يروا إِلى ما خلق اللّه
من شيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سُجّداً للّه وهم داخرون)( داخر: في
الأصل من مادة (دخور) أيْ: التواضع.). |
|
|
الآيات(51) (55)
وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُوا إِلهَيْنَ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ وحِدٌ
فَإِيَّىَ فَارْهَبُونِ
|
|
|
وَقَالَ اللَّهُ
لاَ تَتَّخِذُوا إِلهَيْنَ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ وحِدٌ فَإِيَّىَ
فَارْهَبُونِ(51) وَلَهُ مَا فِى السَّمَوتِ وَالأَْرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ(52) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَة فَمِنَ
اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُون(53) ثُمَّ إِذا
كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ(54)
لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(55) |
|
|
التّفسير |
|
|
دين حق ومعبود واحد:
|
|
|
تتناول هذه الآيات موضوع نفي
الشرك تعقيباً لبحث التوحيد ومعرفة اللّه عن طريق نظام الخلق الذي ورد في الآيات
السابقة، لتتّضح الحقيقة من خلال المقارنة بين الموضوع، ويبتدأ بـ: (وقال اللّه
لا تتخذوا إِلهين اثنين إنّما هو إِله واحد فإِيّاي فارهبون). فعندما يثبت أن عالم الوجود
منه، وهو الذي أوجد جميع قوانينه التكوينية فينبغي أن تكون القوانين التشريعية
من وضعه أيضاً، ولا تكون طاعة إِلاّ له سبحانه. |
|
|
الآيات(56) (60)
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَيَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنهُمْ تَاللَّهِ
لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
|
|
|
وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لاَيَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ
عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ(56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنتِ سُبْحنَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ(57) وَإِذابُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُْنثى ظَلَّ
وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ(58) يَتَورَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرابِ أَلاَ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ(59) لِلَّذِينَ لاَيُؤمِنُونَ بِالأَْخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَى وَهُوَ الْعَزِيَزُ الْحَكِيمُ(60) |
|
|
التّفسير |
|
|
عندما كانت ولادة البنت عاراً!
|
|
|
بعد أن عرضت الآيات السابقة
بحوثاً استدلالية في نفي الشرك وعبادة الأصنام، تأتي هذه الآيات لتتناول قسماً
من بدع المشركين وصوراً من عاداتهم القبيحة، لتضيف دليلا آخراً على بطلان الشرك
وعبادة الأصنام، فتشير الآيات إِلى ثلاثة أنواع من بدع وعادات المشركين: وتقول أوّلاً: (ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً ممّا رزقناهم)( ذكر المفسّرون
رأيين في تفسير «ما لا يعلمون» وضميرها: |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ لماذا اعتبروا الملائكة بناتاً لله؟
|
|
|
تطالعنا الكثير من آيات
القرآن الكريم بأنّ المشركين كانوا يقولون بأنّ الملائكة بنات اللّه جلّ وعلا،
أو أنّهم كانوا يعتبرون الملائكة إِناثاً دون نسبتها إِلى اللّه.. يمكن أن تكون هذه الإِعتقادات
بقايا خرافات الأقوام السابقة التي وصلت عرب الجاهلية، أو ربما يحصل هذا الوهم
بسبب ستر الملائكة عنهم وحال الإِستتار أكثر ما يختص بحال النساء، ولهذا تعتبر
العرب الشمس مؤنثاً مجازياً والقمر مذكراً مجازياً أيضاً، على اعتبار أنّ قرص
الشمس لا يمكن للناظر إِليه أن يديم النظر لأنه يستر نفسه بقوة نوره، أمّا قرص
القمر فظاهر للعين ويسمح للنظر إِليه مهما طالت المدّة. |
|
|
2 ـ لماذا شاع وأد البنات في
الجاهلية؟
|
|
|
الوأد في واقعه أمرٌ رهيب،
لأنّ الفاعل يقوم بسحق كل ما بين جوانحه من عطف ورحمة، ليتمكن من قتل إِنسان
بريء ربّما هو من أقرب الأشياء إِليه من نفسه! (قاموس
الرجال، ج5، ص 125 (مضموناً).) |
|
|
3
ـ دور الإِسلام في إِعادة اعتبار المرأة:
|
|
|
لم يكن احتقار المرأة مختصاً
بعرب الجاهلية، فلم تلق المرأة أدنى درجات الإِحترام والتقدير حتى في أكثر
الأُمم تمدناً في ذلك الزمان، وكانت المرأة غالباً ما يتعامل معها باعتبارها
بضاعة وليست إِنساناً محترماً، ولكنّ عرب الجاهلية جسدوا تحقير المرأة بأشكال
أكثر قباحة ووحشية من غيرهم، حتى أنّهم ما كانوا يدخلونهن في الأنساب كما نقرأ ذلك في الشعر الجاهلي المعروف: |
|
|
الآيات(61) (64)
وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن
دَابَّة
|
|
|
وَلَوْ يُؤاخِذُ
اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة وَلكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّىً فَإِذا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ
يَسْتَئْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ(61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا
يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى
لاَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ(62) تَاللَّهِ لَقَدْ
أَرْسَلنَا إِلى أُمَم مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْملَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ(63) وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتبَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً
وَرَحْمَةً لِقَوم يُؤْمِنُونَ(64) |
|
|
التّفسير |
|
|
وسعت رحمته غضبه:
|
|
|
بعد أن تحدثت الآيات السابقة
عن جرائم المشركين البشعة في وأدهم للبنات، يطرق بعض الأذهان السؤال التالي:
لماذا لم يعذب اللّه المذنبين بسرعة نتيجة لما قاموا به من فعل قبيح وظلم فجيع؟! والآية الأُولى
(61) تجيب بالقول: (ولو يؤاخذ اللّه الناس بظلمهم ما ترك
عليها من دابة)( ـ إِن ضمير «عليها» يعود إِلى «الأرض»
وإِنْ لم يرد لها ذكر في الآيات المتقدمة لوضوح الأمر، ونظائر ذلك كثيرة في لغة
العرب.). |
|
|
بحث
|
|
|
ما هو الأجل المسمى؟
|
|
|
للمفسّرين بيانات
كثيرة بشأن المراد من «الأجل المسمى» ولكن بملاحظة سائر الآيات
القرآنية، ومن جملتها الآية (2) من سورة الأنعام،
والآية (34) من سورة الأعراف، يبدو أنّ المراد منه وقت حلول الموت، أيْ:
إِنَّ اللّه عزَّوجلّ يمهل الناس إِلى آخر عمرهم المقرر لهم إِتماماً للحجة
عليهم، ولعل مَنْ ظلم يعود إِلى رشده ويصلح شأنه فيكون ذلك العود سبباً لرجوعه إِلى
بارئه الحق وإِلى العدالة. واحتمل بعض
المفسّرين أيضاً أنّ «الحسنى»
تعني نعمة الأولاد الذكور، لأنّهم يعتبرون البنات سوءاً وشرّاً، والبنين نعمةً
وحسنى. ولهذا.. (ولهم عذاب
أليم). |
|
|
الآيات(65) (67)
وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمآءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا
|
|
|
وَاللَّهُ أَنْزَلَ
مِنَ السَّمآءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِى
ذلِكَ لأََيَةً لِقَوْم يَسْمَعُونَ(65) وَإِنَّ لَكُمْ فِى الأَْنْعمِ
لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْث وَدَم لَّبَناً
خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّرِبِينَ(66) وَمِن ثَمَرتِ النَّخِيلِ وَالأَْعْنبِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إَنَّ فِى ذلِكَ لأََيَةً
لِقَوْم يَعْقِلُونَ(67) |
|
|
التّفسير |
|
|
المياه، الثمار، الأنعام:
|
|
|
مرّة أُخرى، يستعرض القرآن
الكريم النعم والعطايا الإِلهية الكثيرة، تأكيداً لمسألة التوحيد ومعرفة اللّه،
وإِشارة إِلى مسألة المعاد، وتحريكاً لحس الشكر لدى العباد ليتقربوا إِليه
سبحانه أكثر، ومن خلال هذا التوجيه الرّباني تتّضح علاقة الربط بين هذه الآيات
وما سبقها من آيات. |
|
|
بحوث : كيف يتكوّن اللبن؟ أهم ما في اللبن من مواد غذائية غذاء
خالص وسهل الهضم
|
|
|
1 ـ
كيف يتكوّن اللبن؟ يقول القرآن الكريم في ذلك
كما في الآيات أعلاه: إنّه يخرج من بين «فرث» ـ الأغذية
المهضومة داخل المعدة ـ و «دم». أمّا سكر اللاكتوز
الموجود في اللبن فيؤخذ من السكر
الموجود في الدم بعد أن تجري عليه الغدد الخاصّة في الثدي التغييرات اللازمة
لتحويله إِلى نوع جديد من السكر. |
|
|
الآيتان(68) (69)
وَأَوْحى رَبُّكَ إِلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَاً
وَمِنَ الشَّجَرِ
|
|
|
وَأَوْحى رَبُّكَ
إِلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَاً وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ(68) ثمّ كُلِى مِن كُلِّ الَّثمَرتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ
رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِن بُطُونِها شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْونُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (69) |
|
|
التّفسير |
|
|
(وأوحى
ربّك إِلى النحل)!
|
|
|
انتقل الأسلوب القرآني بهاتين
الآيتين من عرض النعم الإِلهية المختلفة وبيان أسرار الخليقة إِلى الحديث عن
«النحل» وما يدره من منتوج (العسل) ورمز إِلى ذلك الالهام الخفي بالوحي الإِلهي
إِلى النحل: (أن اتّخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر
وممّا يعرشون). |
|
|
1
ـ ما هو «الوحي»
|
|
|
«الوحي» في
الإصل (كما يقول الراغب في مفرداته) بمعنى
الإِشارة السريعة، ثمّ بمعنى الالقاء الخفى. |
|
|
2
ـ هل يختص الإِلهام الغريزي بالنحل؟
|
|
|
وإِذا كان وجود الغرائز
(الإِلهام الغريزي) غير منحصر بالنحل دون جميع الحيوانات، فلماذا ورد ذكره في
الآية في النحل خاصّة؟ |
|
|
3 ـ المهمّة
الأُولى في حياة النحل:
|
|
|
وأوّل مهمّة أمر بها النحل في
هذه الآية هي: بناء البيت، ولعل ذلك إِشارة إِلى أن اتّخاذ المسكن المناسب
بمثابة الشرط الأوّل للحياة، ومن ثمّ القيام ببقية الفعاليات، أو لعله إِشارة
إِلى ما في بيوت النحل من دقة ومتانة، حيث أن بناء البيوت الشمعية والسداسية
الأضلاع، والتي كانت منذ ملايين السنين وفي أماكن متعددة ومختلفة، قد يكون أعجب
حتى من عمليه صنع العسل(عُرِفَ لحد الآن (4500) نوعاً
من النحل الوحشي، والعجيب أنّها في حال واحدة من حيث: الهجرة، بناء الخلايا،
المكان، تناول رحيق الأزهار، أوّل جامعة، الجزء الخامس.). |
|
|
4
ـ اين مكان النحل:
|
|
|
وقد عيّنت الآية المباركة
مكان بناء الخلايا في الجبال، وبين الصخور وانعطافاتها المناسبة، وبين أغصان
الإشجار، وأحياناً في البيوت التي يصنعها لها الإِنسان. |
|
|
بحوث قيمة: مم يتكون العسل، أين يصنع العسل؟ ،ألوانه، عجائب حياة النحل
|
|
|
وفي الآية جملة
بحوث قيمة أُخرى: 3 ـ
أين يصنع العسل؟ 5 ـ
العسل .. والشفاء من الأمراض: ويقول العلماء: لا ينبغي حفظ العسل في أواني فلزية. 8 ـ
عجائب حياة النحل إِنّ روح الخلية تأمر النحل
المهندس والبناء والعامل ببناء البيوت، وهي التي تأمر سكنة المدينة جميعاً
بالهجرة منها في يوم معين وساعة معينة، وتتجه نحو حوادث ومشاق غير معلومة من أجل
تحصيل مسكن ومأوى جديد! |
|
|
الآيات(70) (72)
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُم وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلى
أَرْذَلِ الْعُمُرِ
|
|
|
وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُم وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَىْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ(70) وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِى الرَّزْقِ فَمَا
الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ(71) وَاللَّهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبتِ أَفَبِالْبطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ(72) |
|
|
التّفسير |
|
|
سبب اختلاف الأرزاق:
|
|
|
بيّنت الآيات السابقة قسماً
من النعم الإِلهية المجعولة في عالمي النبات والحيوان، لتكون دليلا حسياً
لمعرفته جل شأنه، وتواصل هذه الآيات مسألة إِثبات الخالق جل وعلا بأسلوب آخر،
وذلك بأن تغيير النعم خارج عن اختيار الإِنسان، وذلك كاشف بقليل من الدقة
والتأمل على وجود المقدّر لذلك. فيبتدأ القول بـ
(واللّه خلقكم ثمّ يتوفاكم). |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ أسباب الرزق:
|
|
|
على الرغم ممّا ذكر بخصوص
التفاوت من حيث الإِستعداد والمواهب عند الناس، إِلاّ أنّ أساس النجاح يمكن في
السعي والمثابرة والجد، فالأكثر سعياً أكثر نجاحاً في الحياة والعكس صحيح. |
|
|
2
ـ مواساة الآخرين:
|
|
|
أشارت الآيات إِلى بخل كثير
من الناس ممن لم يتّبعوا سلوك وهدي الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)، وقد أكّدت
الرّوايات في تفسيرها لهذه الآيات على المساواة والمواساة ومنها: ما جاء في
تفسير علي بن إِبراهيم في ذيل الآية: «لا يجوز الرجل أن يخص نفسه بشيء من
المأكول دون عياله»( تفسير نور الثقلين، ج3، ص68.). |
|
|
الآيتان(73) (74)
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ
السَّمواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً
|
|
|
وَيَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمواتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً
وَلاَ يَسْتَطِيعُون(73) فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهَ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(74) |
|
|
التّفسير |
|
|
لا تجعلوا لله شبيهاً:
|
|
|
تواصل هاتان
الآيتان بحوث التوحيد السابقة، وتشير
إِلى موضوع الشرك، وتقول بلهجة شديدة ملؤها اللوم والتوبيخ: (ويعبدون من دون اللّه ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات
والأرض شيئاً). |
|
|
الآيات(75) (77)
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَمَنْ
رَّزَقْنهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً
|
|
|
ضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلا عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَمَنْ رَّزَقْنهُ مِنَّا
رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَووُنَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(75) وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء وَهُوَ كَلٌّ
عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَما يُوَجِّههُّ لاَيَأْتِ بِخَيْر هَلْ يَسْتَوِى هُوَ
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرط مُّسْتَقِيم(76) وَلِلِّهِ غَيْبُ
السَّموتِ وَالأَْرْضِ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَو
هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ(77) |
|
|
التّفسير |
|
|
مثلان للمؤمن والكافر!
|
|
|
ضمن التعقيب على الآيات
السابقة التي تحدثت عن: الإِيمان، الفكر، المؤمنين، الكافرين والمشركين، تشخص
الآيات مورد البحث حال المجموعتين (المؤمنين والكافرين) بضرب مثلين حيين وواضحين
يشبه المثال الأوّل المشركين بعبد مملوك لا يستطيع القيام بأية خدمة لمولاه،
ويشبه المؤمنين بإِنسان غني، يستفيد الجميع من إِمكانياته.. (ضرب اللّه مثلا
عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء). وبعبارة مختصرة
تجيب الآية على كل أبعاد السؤال، فالله
عزَّوجلّ «يعلم غيب السماوات والأرض» فهو حاضر في كل زمان ومكان، وعليه فلا يخفى
عليه شيء أبداً، ولا مفهوم لقولهم إِطلاقاً، وكل شيء يعلمه تعالى شهوداً، وأمّا
تلك العبارات والأحوال فإِنّما تناسب وجودنا الناقص لا غير. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ الإِنسان بين الحرية والأسر
|
|
|
إِنّ مسألة التوحيد والشرك
ليست مسألة عقائدية ذهنية صرفة كما يتوهم البعض وذلك لما لها من آثار بالغة على
كافة أصعدة الحياة، بل وأنّ بصماتها لتراها شاخصة على كافة مرافق ومناحي الحياة
ـ فالتوحيد إِذا دخل قلباً أحياه وغرس فيه عوامل الرّشد والكمال، لانّه بتوسيع
أفق نظر وتفكير الإِنسان بشكل يجعله مرتبطاً بالمطلق. |
|
|
2
ـ دور العدل والإِستقامة في حياة الإِنسان
|
|
|
من الملفت للنظر إِشارة
الآيات إِلى الدعوة للعدل والسير على الصراط المستقيم من بين صفات وشوؤن
الموحدين، لتبيان ما لهذين الأمرين من أهمية في خصوص الوصول إِلى المجتمع
الإِنساني السعيد، وهو ما يتم من خلال امتلاك برنامج صحيح بعيد عن أي انحراف
يميناً أو شمالا (لا شرقي ولا غربي)، ومن ثمّ الدعوة لتنفيذ ذلك البرنامج المبني
على أُصول العدل، كما وينبغي أن لا يكون البرنامج وقتياً ينتهي بانقضاء المدّة،
بل كما يقول القرآن: (يأمر بالعدل) (حيث يعطي الفعل المضارع معنى الإِستمرار)
برنامج مستمر ودائمي. |
|
|
3
ـ أمّا الرّوايات الواردة عن أهل البيت(عليهم السلام)
|
|
|
الرّوايات الواردة عن أهل
البيت(عليهم السلام) بخصوص تفسير هذه الآية تذكر أنّ: «الذي يأمر بالعدل أمير
المؤمنين والأئمّة صلوات اللّه عليهم»( نور الثقلين،
ج3، ص70.). |
|
|
الآيات(78) (83)
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهتِكُمْ لاَتَعْلَمُونَ شَيْئاً
|
|
|
وَاللَّهُ
أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهتِكُمْ لاَتَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالأَْبْصرَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ
يَرَوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرت فِى جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فِى ذلِكَ لأََيت لَّقَوْم يُؤْمِنُونَ(79) وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ
الأَْنْعمِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم
وَمَنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثثاً وَمَتعاً إِلى
حِين(80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِللا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ
الْجِبَالِ أَكْنَناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَربِيلَ تَقِبكُمُ الْحَرَّ وَسَربِيلَ
تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذلك يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْلِمُونَ(81) فإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلغُ المُبِينُ(82)
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَها وَأَكثَرُهُمُ الْكفِرُونَ (83) |
|
|
التّفسير |
|
|
أنواع النعم المادية والمعنوية:
|
|
|
يعود القرآن الكريم مرّة
أُخرى بعرض جملة أُخرى من النعم الإِلهية كدرس في التوحيد ومعرفة اللّه، وأوّل
ما يشير في هذه الآيات المباركات إِلى نعمة العلم والمعرفة ووسائل تحصيله..
ويقول: (واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئاً). |
|
|
ملاحظات
|
|
|
1
ـ بداية الإِدراك عند الإِنسان
|
|
|
وهنا نطرح
الملاحظات التالية: |
|
|
2
ـ نعمة وسائل المعرفة
|
|
|
ممّا لا شك فيه عدم امكانية
استيعاب ودخول العالم الخارجي في وجودنا، والحاصل الفعلي هو رسم صورة الشيء
الخارجي المراد في الذهن وبواسطة الوسائل المعينة لذلك، وعليه.. فمعرفتنا بالعالم
الخارجي تكون عن طريق أجهزة خاصّة منها السمع والبصر. ونشاهد تقديم ذكر السمع على
البصر في الآية مع ما للعين من عمل أوسع من السمع، ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل
على العين بعد الولادة، حيث أنّ العين كانت في ظلام دامس (في رحم الأم) ونتيجة
لشدّة أشعة النّور (بعد الولادة) فإِنّها لا تستطيع العمل مباشرة بسبب حساسيتها،
وإِنّما تتدرج في اعتيادها على مواجهة النّور حتى تصل للحالة الطبيعية المعتادة،
ولذا نجد الوليد في بداية أيّامه الأُولى مغلق العين. أمّا بخصوص الأذن.. فثمة
مَنْ يعتقد بأنّ لها القدرة على السماع (قليلا أو كثيراً) وهي في عالم الأجنّة
وأنّها تسمع دقات قلب الأم وتعتاد عليها! |
|
|
3
ـ لعلكم تشكرون
|
|
|
تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم
من أفضل النعم التي وهبها اللّه للإِنسان، فلا يقتصر دور العين والأذن (مثلا)
على النظر إِلى آثار اللّه في خلقه، والإِستماع إِلى أحاديث أنبياء اللّه
وأوليائه، وتفهم ذلك وتدركه بالتحليل والإِستنتاج، بل إِنّ كل خطوة نحو التكامل
والتقدم مرتبطة إِرتباطاً وثيقاً بهذه الوسائل الثلاثة. |
|
|
بحوث
|
|
|
1 ـ أسرار تحليق
الطيور في السماء
|
|
|
إِنّنا لا نشعر بأهمية الكثير
من عجائب عالم الوجود لاعتيادنا على كثرة مشاهدتها ولعدم انشغالنا بالتدقيق
العلمي عند المشاهدة، حتى باتت هذه العادة كحجاب يغطي تلك العظمة، ولو استطاع
أيٍّ منّا رفع ذلك الحجاب عن ذهنه لرأى العجائب الكثيرة من حوله. |
|
|
2
ـ ترابط الآيات:
|
|
|
لا شك أنّ هناك ترابطاً بين
الآية أعلاه والتي تتحدث عن كيفية طيران الطيور وما قبلها من الآيات يتمثل في
الحديث عن نعم اللّه عزَّ وجلّ في عالم الخليقة، وعن أبعاد عظمته وقدرته سبحانه
وتعالى، ولكن لا يبعد أن يكون ذكر تحليق الطيور بعد ذكر آلات المعرفة يحمل بين
طياته إِشارة لطيفة في تشبيه تحليق هذه الطيور في العالم المحسوس بتحليق الأفكار
في العالم غير المحسوس، فكلُّ منها يحلق في فضائه الخاص وبما لديه من آلات. |
|
|
3
- الظلال، المساكن، الأغطية:
|
|
|
ويشير القرآن الكريم إِلى نعمة أُخرى بقوله: (واللّه
جعل لكم ممّا خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناناً). «الأكنان»: جمع (كن) بمعنى وسائل التغطية والحفظ، ولهذا فقد أُطلقت
على المغارات وأماكن الإِختفاء وفي الجبال. ويشاهد في القرآن الكريم
مقاطع قرآنية تطلق الكفر على ذلك النوع الناشىء من التكّبر والعناد، ومنها ما
يتحدث عن الشيطان كما جاء في الآية (34) من سورة البقرة
(أبى واستكبر وكان من الكافرين). |
|
|
بحثان: 1 ـ كلمات المفسّرين، 2 ـ صراع الحقّ مع الباطل
|
|
|
1 ـ
كلمات المفسّرين |
|
|
الآيات(84) (89)
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيداً ثُمَّ لاَيُؤْذَنُ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
|
|
|
وَيَوْمَ نَبْعَثُ
مِن كُلِّ أُمَّة شَهِيداً ثُمَّ لاَيُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ(84) وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ(85) وَإِذا رَءَا الَّذِينَ
أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤُلاءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ
كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكذِبُونَ(86) وَأَلْقَوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم
مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ(87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
زِدْنهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ(88) وَيَوْمَ
نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّة شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجئْنا بِكَ
شَهِيداً عَلَى هَؤُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتبَ تِبْيناً لِّكُلِّ
شَىْء وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(89) |
|
|
التّفسير |
|
|
عندما
تغلق الأبواب أمام المجرمين:
|
|
|
بعد أن عرض القرآن الكريم في
الآيات السابقة جحود منكري الحق وعدم اعترافهم بالنعم الإِلهية، يتطرق في هذه
الآيات إِلى جانب من العقاب الإِلهي الشديد الذي ينتظر أُولئك في عالم الآخرة،
لينبه الغافل من سباته، فعسى أنْ يعيد النظر في مواقفه المنحرفة قبل فوات
الأوان، فيقول أوّلاً: (ويوم نبعث من كل أُمّة شهيداً)(
ألـ «يوم» هنا ظرفٌ متعلق بفعل مقدّر، وأصل العبارة: (وليذكروا) أو (واذكروا).). وعندها... تبدأ تلك الأصنام
بالتكلم (بإِذن اللّه): (فألقوا إِليهم القول إِنّكم لكاذبون)، فلم نكن شركاء
لله، ومهما وسوسنا لكم فلا نستحق حمل بعض أوزاركم. 4 ـ لعل ورود
جملة (فألقوا إِليهم القول) بدل «قالوا لهم» لعدم قدرة الأصنام على التكلم
بنفسها، فيكون قولها عبارة عن إِلقاء من قبل اللّه فيها، أيْ أنّ اللّه عزَّوجلّ
يلقي إِليها، وهي بدورها تلقية إِلى المشركين. |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ القرآن تبيان لكل شيء:
|
|
|
من أهم ما تطرقت له الآيات
المباركات هو أنّ القرآن مبين لكل شيء. |
|
|
2
ـ مراحل الهداية الأربع
|
|
|
إِنّ الآية أعلاه
ذكرت أربعة تعابير متلازمة حسب تسلسلها لتوضيح الهدف من نزول القرآن: |
|
|
الآية(90) إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسنِ وَإِيتَآىءِ ذِى الْقُرْبى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ
|
|
|
إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسنِ وَإِيتَآىءِ ذِى الْقُرْبى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ وَالْبَغِى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(90) |
|
|
التّفسير |
|
|
أكمل برنامج إِجتماعي:
|
|
|
بعد أن ذكرت الآيات السابقة
أنّ القرآن فيه تبيان لكل شيء، جاءت هذه الآية المباركة لتقدم نموذجاً من
التعليمات الإِسلامية في شأن المسائل الإِجتماعية والإِنسانية والأخلاقية، وقد
تضمّنت الآية ستة أُصول مهمّة، الثلاث الأوّل منها ذات طبيعة إِيجابية ومأمور
بالعمل بها، والبقية ذات صفة سلبية منهي عن ارتكابها. |
|
|
الآيات(91) (94)
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عهَدتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمنَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
|
|
|
وَأَوْفُوا
بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عهَدتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمنَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ(91) وَلاَتَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّة أَنكَثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ
تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمَّة إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ(92) وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وحِدَةً وَلكِن
يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ(93)وَلاَتَتَّخِذُوا أَيْمنَكُمْ دَخَلاًَ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ
قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
يقول المفسّر
الكبير العلاّمة الطبرسي في (مجمع البيان) في شأن نزول أوّل آية من هذه الآيات أنّها نزلت في الذين بايعوا النّبي(ص)
على الإِسلام (وكان من المحتمل أن ينقض بعضهم البيعة لقلّة المسلمين وكثرة
الأعداء)، فقال سبحانه مخاطباً لهم لا يحملنّكم قلّة المسلمين وكثرة المشركين
على نقض البيعة). |
|
|
التّفسير |
|
|
الوفاء بالعهد دليل الإِيمان:
|
|
|
بعد أن عرض القرآن الكريم في
الآية السابقة بعض أصول الإِسلام الأساسية (العدل، والإِحسان، وما شابههما)،
يتناول في هذه الآيات قسماً آخر من تعاليم الإِسلام المهمّة (الوفاء بالعهد
والأيمان). |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ فلسفة احترام العهد
|
|
|
كما هو معلوم فإِنّ الثقة
المتبادلة بين أفراد المجتمع تمثل أهم دعائم رسوخ المجتمع، بل من دعائم تشكيل
المجتمع وإِخراجه من حالة الآحاد المتفرقة وإِعطائه صفة التجمع، وبالإِضافة لكون
أصل الثقة المتبادلة يعتبر السند القويم للقيام بالفعاليات الإِجتماعية والتعاون
على مستوى واسع. |
|
|
2
ـ ما لا يقبل في نقض العهود:
|
|
|
إِنّ قبح نقض العهد الشناعة
بحيث لا احداً على استعداد لأن يتحمل مسؤوليته بصراحة إلاّ النادر من الناس حتى
أن ناقض العهد يلتمس لذلك اعذاراً وتبريرات مهما كانت واهية لتبرير فعلته. وقد
ذكرت لنا الآيات أعلاه نموذجاً لذلك.. فبعض المسلمين يتذرعون بحجج واهية ككثرة
الأعداء وقلة المؤمنين للتنصل من عهودهم مع اللّه والنّبي(ص) فتكون مواقفهم
متزلزلة، في حين أنّ الأكثرية من حيث العدد لا تمثل القدرة والقوة في واقع
الحال، وانتصار القلّة المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة من الشواهد المعروفة في
تأريخ البشرية، ثمّ إِنّ حصول القدرة والقوة للأعداء ـ على فرض حصولها ـ لا تسوغ
لأن تكون مبرراً مقبولا لنقض العهد، ولو دققنا النظر في الإمر لرأينا في واقعه
أنّه نوع من الشرك والجهل باللّه عزَّوجلّ. |
|
|
الآيات(95) (97) وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
|
|
|
وَلاَ تَشْتَرُوا
بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(95) مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ(96)مَنْ عَمِلَ صلِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(97) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
نقل المفسّر الكبير
العلاّمة الطبرسي عن ابن عباس قوله: إِنّ رجلا من حضرموت يقال له عيدان الأشرع قال: يا رسول اللّه، إِنّ امرأ
القيس الكندي جاورني في أرضي فاقتطع من أرضي فذهب بها منّي، والقوم يعلمون إِنّي
لصادق، ولكنّه أكرم عليهم منّي، فسأل رسول اللّه اُمرأ القيس عنه فقال: لا أدري
ما يقول، فأمره أنْ يحلف. فقال عيدان: إِنّه فاجر لا يبالي أنْ يحلف، فقال: إِنْ
لم يكن لك شهود فخذ بيمينه، فلماذا قام ليحلف أنظره فانصر فافنزل قوله:
(ولاتشتروا وابعهد اللّه...) الآيتان فلمّا قرأهما رسول اللّه(صلى الله عليه
وآله وسلم)قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي فينفد وهو صادق فيما يقول، لقد اقتطعت
أرضه ولم أدرِ كم هي، فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما أكلت من ثمرها،
فنزل فيه (مَنْ عمل صالحاً...)الآية. |
|
|
التّفسير |
|
|
ثمن الحياة الطيبة:
|
|
|
جاءت الآية الأُولى من هذه الآيات لتؤكّد على قبح نقض العهد مرّة أُخرى
ولتبيّن عذراً آخراً من أعذار نقض العهد الواهية، فحيث تطرقت الآيات السابقة
إِلى عذر الخوف من كثرة الأعداء تأتي هذه الآية لتطرح ما للمصلحة الشخصية
(المادية) من أثر سلبي على حياة الإِنسان. ولا تخلو جملة (ولنجزين الذين صبروا...) من الإِشارة إِلى أنّ الصبر
والثبات في السير على طريق الطاعة، وخصوصاً حفظ العهود والإِيمان هي من أفضل
أعمال الإِنسان. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ منابع الخلود
|
|
|
إِنّ طبيعة الحياة في هذا
العالم المادي هي الفناء والهلاك، فأقوى الأبنية وأكثر الحكومات دواماً وأشد
البشر قدرة لا يعدون أن يصيروا في نهاية أمرهم إِلى الضعف فالفناء، وكل شيء معرض
للتلف بلا استثناء في هذا الأمر. |
|
|
2
ـ التساوي بين الرجل والمرأة
|
|
|
ممّا لا شك فيه أنّ بين الرجل
والمرأة تفاوت واختلاف من الناحيتين الجسمية والروحية، وهذا الفرق هو الذي
جعلهما مختلفين في وظائفها وشؤونهما الإِجتماعية، إِلاّ أنّ طبيعة الإِختلاف
الموجود لا تنعكس على الشخصية الإِنسانية، ولا توجد اختلافاً في مقامهما عند
اللّه عزَّوجلّ، فهما في هذا الجانب متساويان ومتكافئان، ويحكم شخصية أي منهما
مقياس واحد ألا وهو الإِيمان والعمل الصالح والتقوى، وإِمكانية تحصيل ذلك لأيٍّ
منهما متساوية. |
|
|
3 ـ جذور العمل
الصالح ترتوي من الإِيمان
|
|
|
العمل الصالح: مصطلح له من سعة المفهوم ما يضم بين طياته جميع الأعمال
الإِيجابية والمفيدة والبناءة على كافة أصعدة الحياة العلمية والثقافية
والإِقتصادية والسياسية والعسكرية...الخ. |
|
|
4
ـ ما هي الحياة الطيبة؟
|
|
|
لقد ذكر المفسّرون في معنى
الحياة الطيبة تفاسير عديدة: وبملاحظة تعبير الآية عن
الجزاء الإِلهي وفق أحسن الأعمال، ليفهم من ذلك أنّ الحياة الطيبة ترتبط بعالم
الدنيا بينما يرتبط الجزاء بالأحسن بعالم الآخرة. |
|
|
الآيات(98) (100) فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطنِ الْرَّجِيمَ
|
|
|
فَإِذا قَرَأْتَ
الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطنِ الْرَّجِيمَ(98)إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوَا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ(99) إِنَّمَا سُلْطنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ
وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ(100) |
|
|
التّفسير |
|
|
إِقرأ
القرآن هكذا:
|
|
|
لم يفت ذاكرتنا ما ورد قبل
عدّة آيات أنّ القرآن (تبياناً لكل شيء) ثمّ تمّ البحث عن قسم من أهم الأوامر
الإِلهية في القرآن. |
|
|
بحوث
|
|
|
1 ـ موانع
المعرفة
|
|
|
مع كل ما للحقيقة من ظهور
ووضوح فإِنّها لا تلحظ إِلاّ بعين باصرة، وبعبارة أُخرى، ثمة شرطان لمعرفة
الحقائق: لأنّه قد أوجد الأحكام
المسبقة الخاطئة عنده، وسمح للأهواء النفسية والتعصبات العمياء المتطرفة أن
تتغلب على توجهه، ووقع في أسر الذات والغرور، ولوث صفاء قلبه وطهارة روحه بأُمور
قد جعلها موانع أمام فهم وإِدراك الحقائق. |
|
|
2
ـ لماذا يكون التعوذ «من الشيطان الرجيم»؟
|
|
|
«الرجيم»: من
(رجم)، بمعنى الطرد، وهو في الأصل بمعنى الرمي بالحجر ثمّ استعمل في الطرد. ونلاحظ ذكر صفة طرد
الشيطان من دون جميع صفاته، للتذكير بتكبّره
على أمر اللّه حين أمره بالسجود والخضوع لآدم، وإِنّ ذلك التكبّر الذي دخل
الشيطان بات بمثابة حجاب بينه وبين إِدراك الحقائق، حتى سولت له نفسه أن يعتقد
بأفضليته على آدم وقال: (أنا خير منه خلقتني من نار
وخلقته من طين). |
|
|
3 ـ بين لوائي
الحقّ والباطل
|
|
|
قسمت الآيات أعلاه الناس إِلى
قسمين: قسم يرزح تحت سلطة الشيطان وقسم خارج عن هذه السلطة، وبيّنت صفتين لكلٍّ
من هذين القسمين: |
|
|
4
ـ آداب تلاوة القرآن:
|
|
|
كل شيء يحتاج الى برنامج معين
ولا يستثنى كتاب عظيم ـ كالقرآن الكريم ـ من هذه القاعدة، لذلك فقد ذكر في
القرآن بعض الآداب والشروط لتلاوة كلام اللّه والإِستفادة من آياته: |
|
|
الآيات(101) (105)
وَإِذا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر
|
|
|
وَإِذا بَدَّلْنَا
ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا
أَنْتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ
الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدىً
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَمِىٌّ
وَهَذا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ(103) إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ
بِأَيتِ اللَّهِ لاَيَهْدِيِهمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(104) إِنَّمَا
يَفْتَرِى الكَذِبَ الَّذِينَ لاَيؤْمِنُونَ بِأَيتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكذِبُونَ(105) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
يقول ابن عباس: (كانوا يقولون: يسخر محمّد بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر
وغداً يأمرهم بأمر، وإِنّه لكاذب، يأتيهم بما يقول من عند نفسه). |
|
|
التّفسير |
|
|
الإِفتراء!
|
|
|
تحدثت الآيات السابقة أُسلوب
الإِستفادة من القرآن الكريم، وتتناول الآيات مورد البحث جوانب أُخرى من المسائل
المرتبطة بالقرآن، وتبتدىء ببعض الشبهات التي كانت عالقة في أذهان المشركين حول
الآيات القرآنية المباركة، فتقول: (وإِذا بدّلنا آية
مكان آية واللّه أعلم بما ينزّل) فهذا التغيير والتبديل يخضع لحكمة
اللّه، فهو أعلم بما ينزل، وكيف ينزل، ولكن المشركين لجهلهم (قالوا إِنّما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون). وبعد الإِجابة على
هذه الأسئلة لا يبقى لنا إِلاّ أنْ نقول: ليس النسخ سوى
برنامج مؤقت في مراحل إِنتقالية. نعم، فمع كل ما وصلت إِليه
البشرية من قوانين وأنظمة ما زال القرآن هو المتفوق وسيبقى. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ قبح الكذب في المنظور الإِسلامي
|
|
|
الآية الأخيرة بحثت مسألة قبح
الكذب بشكل عنيف، وقد جعلت الكاذبين بدرجة الكافرين والمنكرين للآيات الإِلهية. |
|
|
2
ـ الكذب منشأ جميع الذنوب:
|
|
|
وقد اعتبرت الأحاديث الشريفة
الكذب مفتاح الذنوب.. |
|
|
3
ـ الكذب منشأ للنفاق:
|
|
|
لأنّ الصدق يعني تطابق اللسان
مع القلب، في حين أن الكذب يعني عدم تطابق اللسان مع القلب، وما النفاق إِلاّ
الإِختلاف بين الظاهر والباطن. |
|
|
4
ـ لا انسجام بين الكذب والإِيمان:
|
|
|
وإِضافة إِلى الآية المباركة
فثمة أحاديث كثيرة تعكس لنا هذه الحقيقة الجليّة... |
|
|
5
ـ الكذب يرفع الإِطمئنان:
|
|
|
إِنّ وجود الثقة والإِطمئنان
المتبادل من أهم ما يربط الناس فيما بينهم، والكذب من الأُمور المؤثرة في تفكيك
هذه الرابطة لما يشيعه من خيانة وتقلب، ولذلك كان تأكيد الإِسلام على أهمية
الإِلتزام بالصدق وترك الكذب. |
|
|
الآيات(106)
(111) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمنِ
|
|
|
مَن كَفَرَ
بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالإِيمنِ وَلكِنَ مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا
الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الأَْخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِى الْقَومَ
الْكَفِرِينَ(107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ
وَأَبْصرِهِمْ وَأُلَئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ(108) لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى
الأَْخِرَةِ هُمُ الْخسِرُونَ(109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
مِن بَعْدِ مَافُتِنُوا ثمّ جهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(110) يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نِفْس تُجدِلُ عَن نَّفْسِهَا
وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ(111) |
|
|
سبب النّزول
|
|
|
ذكر بعض المفسّرون في شأن نزول الآية الأُولى من هذه الآيات أنّها: نزلت في
جماعة أُكرهوا ـ وهو: عمار وأبوه ياسر وأُمّة سمية
وصهيب وبلال وخبّاب ـ عُذِّبُوا وقُتِل أبو عمار وأَمّه وأعطاهم عمار
بلسانه ما أرادوا منه، ثمّ أخبر سبحانه بذلك رسوله(ص)، فقال قوم: كفر عمّار.
فقال(ص) كلا: «إِنّ عماراً مليء إِيماناً من قرنه إِلى قدمه واختلط الإيمان
بلحمه دمه».. وجاء عمّار إِلى رسول اللّه وهو يبكي، فقال النّبي(ص): «ما وراءك»؟
فقال: شرّ يا رسول اللّه، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسول
اللّه(ص) يمسح عينيه ويقول: «إِنْ عادوا لك فعد لهم بما قلت»، فنزلت الآية. |
|
|
التّفسير |
|
|
المرتدون عن الإِسلام:
|
|
|
تكمل هذه الآيات ما شرعت به
الآيات السابقة من الحديث عن المشركين والكفار وما كانوا يقومون به، فتتناول الآيات فئة أُخرى من الكفرة وهم المرتدون. |
|
|
بحثان
|
|
|
1
ـ التقية وفلسفتها:
|
|
|
إِمتاز المسلمون الأوائل
الذين تربّوا على يد النّبي(ص) بروح مُقاومة عظيمة أمام أعدائهم، وسجل لنا
التأريخ صوراً فريدة للصمود والتحدي، وها هو «ياسر» لم يلن ولم يدخل حتى الغبطة
الكاذبة على شفاه الأعداء، وما تلفظ حتى بعبارة خالية من أيّ أثر على قلبه ممّا
يطمح الأعداء أن يسمعوها منه، مع أنّ قلبه مملوءاً ولاءً وإِيماناً بالله تعالى
وحبّاً وإِخلاصاً للنّبي(ص) وصبر على حاله رغم مرارتها فنال شرف الشهادة، ورحلت
روحه الطاهرة إِلى بارئها صابرة محتسبة تشكو إليه ظلم وجور أعداء دين اللّه. |
|
|
2
ـ المرتد الفطري والملي و.. المخدوعين:
|
|
|
لايواجه الإِسلام الذين لا
يعتنقون الإِسلام من (أهل الكتاب) بالشدّة والقسوة وإِنّما يدعوهم باستمرار
ويتحدث معهم بالمنطق السليم، فإِذا لم يقتنعوا وراموا البقاء على ديانتهم فيعطون
الأمان والتعهد بحفظ أموالهم وأرواحهم ومصالحهم المشروعة بعد أن يعلنوا قبول شرط
أهل الذمة في عهدهم مع المسلمين. |
|
|
الآيات(112) (114) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً
مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَان
|
|
|
وَضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً
مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ(112) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ
رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فأخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظلِمُونَ(113)
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَللا طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
إِن كُنْتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ(114) |
|
|
التّفسير |
|
|
الذين كفروا فأصابهم العذاب
|
|
|
قلنا مراراً: إِنّ هذه السورة
هي سورة النِعَمْ، النعم المادية والمعنوية وعلى كافة الأصعدة، وقد مرَّ ذكر في
آيات متعددة من هذه السورة المباركة. |
|
|
بحوث
|
|
|
1
ـ أهو مثالٌ أمْ حدثٌ تاريخي؟
|
|
|
لقد عبّرت الآيات أعلاه عند
حديثها عن تلك المنطقة العامرّة بكثرة النعم، والتي أصاب أهلها بلاء الجوع
والخوف نتيجة كفرهم بأنعم اللّه، عبّرت عن ذلك بكلمة «مثلا» وبذات الوقت فإِنّ
الآية استخدمت الأفعال بصيغة الماضي، ممّا يشير إِلى وقوع ما حدث فعلا في زمن
ماض، وهنا حصل اختلاف بين المفسّرين في الهدف من البيان القرآني، فقسمٌ قد احتمل
أنّ الهدف هو ضرب مثال عام، وذهب القسم الثّاني إِلى أنّه لبيان واقعة تأريخية معيّنة. |
|
|
2
ـ الرابطة ما بين الأمن والرّزق الكثير
|
|
|
ذكرت الآيات ثلاث
خصائص لهذه المنطقة العامرّة المباركة: |
|
|
3
ـ لباس الجوع والخوف
|
|
|
ذكرت الآيات في بيان عاقبة
الكافرين بنعم اللّه، قائلةً: (فأذاقها اللّه لباس الجوع والخوف) فمن جهة: شبّهت
الجوع والخوف باللباس، ومن جهة أُخرى: عبّرت بـ «أذاقها» بدلا من (ألبسها). |
|
|
4
ـ أثر كفران النعمة في تضييع المواهب الإِلهية
|
|
|
رأينا في الرّواية المتقدمة
كيف راح أُولئك المرفهون بتطهير أجسادهم بواسطة المواد الغذائية بعد أنْ تسلطت
عليهم الغفلة وساورهم الغرور، حتى ابتلاهم اللّه بالقحط والخوف. |
|
|
الآيات(115) (119) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنزِيِر وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
|
|
|
إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيِر وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ(115)وَلاَ تَقَولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَللٌ
وَهذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ(116) مَتعٌ قَلِيلٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا
قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبلُ وَمَا ظَلَمْنهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ(118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهلَة ثُمَّ
تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ(119) |
|
|
التّفسير |
|
|
لا يفلح الكاذبون:
|
|
|
بعد أنْ تحدثت الآيات السابقة
عن النعم الإِلهية ومسألة شكر النعمة، تأتي الآيات أعلاه لتتحدث عن آخر حلقات
الموضوع وتطرح مسألة المحرمات الواقعية وغير الواقعية لتفصل بين الدين الحق وبين
البدع التي أُحدثت في دين اللّه، وتشرع بالقول: (إِنّما حرّم عليكم الميتة
والدّم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لغير اللّه به)(
أُهِلَّ: من الإِهلال، مأخوذُ من الهلال، بمعنى إِعلاء الصوت عند رؤية الهلال،
وباعتبار أنّ المشركين كانوا إِذا ذبحوا حيواناتهم للأصنام صرخوا عالياً بأسماء
أصنامهم، فقد عبّر عنه بـ «أُهِلَّ».). |
|
|
الآيات(120) (124) إِنَّ إِبْرهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ
حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِينَ
|
|
|
إِنَّ إِبْرهِيمَ
كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْركِينَ(120)شَاكِراً لأَِنْعُمِهِ اجْتَبهُ وَهَدَاهُ إِلى صِراط
مُّسْتَقِيم(121) وءَاتَيْنهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى
الأَْخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ(122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(123) إِنَّمَا
جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَومَ الْقِيمَةِ فِيَما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ(124) |
|
|
التّفسير |
|
|
كان إِبراهيم لوحده أُمّة!
|
|
|
كما قلنا مراراً بأنّ هذه
السورة هي سورة النعم، وهدفها تحريك حس الشكر لدى الإِنسان بشكل يدفعه لمعرفة
خالق وواهب هذه النعم. تساؤل: لماذا لم يحرم في الإِسلام ما كان محرماً في دين اليهود؟
فجاء الجواب أنّ ذلك كان عقاباً لهم، فيطرح السؤال مرّة أُخرى حول عدم حرمة صيد
الأسماك يوم السبت في الأحكام الإِسلامية في حين أنّه محرم على اليهود ..فيكون
الجواب بأنّه كان عقاباً لليهود أيضاً. |
|
|
الآيات(125) (128) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ
|
|
|
ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خيْرٌ للِّصَّبِرِينَ (126)
وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ
فِى ضَيْق مَمَّا يَمْكُرُونَ(127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا
وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ(128) |
|
|
التّفسير |
|
|
عشرة قواعد أخلاقية .. سلاحٌ
داعية الحق: 4 ـ
إِنصب الحديث في الأصول الثلاثة حول البحث المنطقي والأُسلوب العاطفي والمناقشة
المعقولة مع المخالفين، وإِذا حصلت
المواجهة معهم ولم يتقبلوا الحق وراحوا يعتدون، فهنا يأتي الأصل الرابع: (وإِنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). 12
ـ (ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات). 34
ـ (واللّه جعل لكم من بيوتكم سكناً) وهي البيوت الثابتة. وبعد الإِشارة إِلى إِكمال النعم الإِلهية، تقول الآية (81): (لعلّكم تسلمون). |
|
|
|
|
|